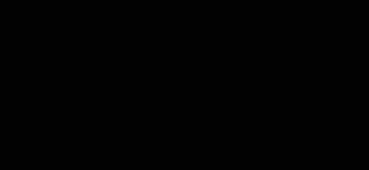*زياد غصن
منذ الأيام الأولى للحرب الأوكرانية، كانت قناعة دمشق مفادها أن الغرب ـ وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية ـ قد لا يتوانى عن القيام بتصعيد ما في الأوضاع السياسية والميدانية في الساحة السورية، انطلاقاً من سياسته المعروفة، والقائمة على الهروب إلى إشاعة الفوضى، ليتسنى له ترتيب أوراقه من جديد، واستنزاف خصمه في عدة جبهات.
ويبدو أن هذا ما بدأ يحدث فعلاً من خلال عودة تنظيم “داعش” إلى الواجهة من جديد، سواء عبر الهجمات التي زاد عددها ضد نقاط الجيش السوري وحافلاته، أو من خلال حضوره العلني في بعض التجمعات السكانية عند أطراف البادية السورية والريف الشرقي، وكذلك عودة “قسد” إلى خيار تأزيم علاقاتها السياسية والاقتصادية بدمشق. ثم تطور الموقف الغربي، ليصل إلى مجموعة أحداث لا يمكن قراءة خلفياتها إلّا في إطار التصعيد المدعوم غربياً، وإن تباينت الأهداف المباشرة لكل طرف وغاياته.
وما يعزز الاستنتاج المشار إليه، ويجعله منطقياً، هو ذلك التزامن المريب بين الأحداث التي تشهدها مناطق الشرق، والشمال، والجنوب السوري، بحيث عادت الأوراق لتختلط من جديد، بين إحياء التهديد الأمني وتوسيع دائرته، كما يحدث في الجنوب، وبين رفع مستوى التهديد العسكري، كما هي حال الموقف التركي في الشمال، وبين الضغط السياسي الذي تتبلور ملامحه أكثر، يوماً بعد يوم، في الشرق السوري. ويلاحظ المتابع لهذه الأحداث أنها، ظاهرياً، غير مرتبطة، بعضها بالبعض الآخر، فلكل طرف فاعل فيها مصالحه ومشروعه المغاير للآخر، لكن عملياً فإن الداعم واحد، بصورة مباشر أو غير مباشرة.
مصالح متعددة في منطقة واحدة
عادت أنقرة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إحياء مشروعها الرامي إلى إقامة “منطقة آمنة” ضمن الأراضي السورية، بذريعة توفير ملاذ آمن لآلاف اللاجئين السوريين الذين سيتم ترحيلهم من تركيا إلى تلك المناطق، في حين أن جوهر المشروع يستهدف إحداث تغيير ديمغرافي شامل يكرس الوجود الاحتلالي لأنقرة في تلك المناطق، التي لا تشكل، في مقوّماتها الاقتصادية، مطمعاً تركياً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الخطوة، أياً يكن شكلها وحدود تنفيذها، تعزز أوراق إردوغان التفاوضية حيال ما يعدّه مصالح حيوية مستقبلية لبلاده في سوريا.
أمّا لماذا عادت تركيا إلى طرح مشروعها القديم، والذي لم يلقَ سابقاً دعماً غربياً مباشِراً، كما أنه لم يُرفض، في الوقت ذاته، فإن الإجابة ليست في حاجة إلى عناء كبير، إذ إن السياسة التركية المعروفة باللعب على التناقضات والتجاذبات الدولية، في مقاربتها للأزمة السورية، لم تشأ أن تفوّت فرصة الاستفادة من الحرب الأوكرانية من أجل تحقيق بعض المكاسب في الجبهة السورية.
فمن ناحية، هي ستضمن موافقة أميركية ضمنية بحكم رغبة واشنطن المتزايدة في تقويض الدور الروسي في سوريا، والضغط أكثر على دمشق، ومن ناحية ثانية، هي ستحاول إجراء مقايضة لذلك مع موسكو، مستغلة دخولها وسيطَ سلام بين موسكو وكييف في الأزمة الحالية. والمقايضة إمّا أن تكون في أوكرانيا، من خلال تخفيض صادراتها من طائرات “بيرقدار” إلى كييف، أو استمرار عرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وإمّا تكون في سوريا من خلال الموافقة على عملية روسية سورية، تستعيد بموجبها دمشق السيطرة على طريق M4 الشهير، والذي يربط حلب باللاذقية. لكن، هل ستذهب أنقرة بالفعل إلى تحقيق مشروع “المنطقة الآمنة”، أم ستكتفي بقضم تدريجي لبعض المناطق في الشمال السوري؟
أغلبية التحليلات السياسية تذهب نحو ترجيح الخيار الثاني، بالنظر إلى أن الخيار الأول سيكون في منزلة انقلاب في السياسات الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السورية. والأهم أنه قد يفتح الباب لتصادم محتمل في الأرض السورية، وهذا ما تتجنّب جميع الأطراف مجرد فرضية حدوثه حتى الآن، إلّا إذا كانت هناك عواصم تعمل على رسم حدود جديدة للتصادم والمصالح في هذا البلد المنكوب، أو تريد حدوث ذلك.
في الشرق، يمكن قراءة ثلاثة تطورات مهمة، لا يمكن عزل أيّ منها عن سياق مجرى الحديث السابق عن التصعيد الغربي:
– التطور الأول تمثّل بعودة التوتر إلى العلاقة “الهشة” التي تربط دمشق بوحدات “قسد”، وذلك بعد شيوع أنباء عن إبداء الأخيرة استعدادها للتفاوض مع الحكومة السورية وتسليمها المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها حقول النفط والقمح. وهذه أنباء نقلها سياسيون سوريون مع نهاية العام الماضي، بعد اتصالات مباشرة لهم بزعماء من ميليشيا “قسد”، الذين سرعان ما عادوا إلى التشدد في مواقفهم استجابة لضغوط أميركية، بل إن الميليشيا الكردية استولت، في أعقاب ذلك، على مقارَّ لمؤسسات حكومية، بينها مبانٍ عائدة إلى جامعة الفرات ومدارس حكومية وغيرها.
– الإجراءات الأميركية الأخيرة، تمثّلت باستثناء المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” من مفاعيل قانون ما يسمى “قيصر”، ثم تخصيص مبلغ يزيد على 800 مليون دولار كمساعدات للسوريين. وغالباً، فإن القسم الأكبر من هذه المساعدات، سوف يذهب إلى دعم إدارة “قسد”، في مؤسساتها العسكرية والمدنية. بناءً على هذا، فإن الهدف الأميركي بات واضحاً، وهو إحداث تمايز تنموي بين المناطق السورية، تكريساً لواقع جغرافي معين، وتدعيم سيطرة ميليشيا “قسد”، ذات الأهداف الانفصالية، من أجل إبعادها أكثر فأكثر عن أي مسار تفاوضي مع الحكومة السورية.
– عودة الضربات المجهولة لمقارَّ وأهداف تابعة للقوات الحليفة لدمشق في تلك المنطقة، لكن أصابع الاتهام تتجه دوماً نحو الكيان الصهيوني، الذي يستثمر التسهيلات الممنوحة له من جانب القوات الأميركية المتمركزة في منطقة التنف السورية، أو في الدول المجاورة، للقيام باعتداءات جوية. وهي إمّا تُصَنَّف في إطار السعي لمنع حدوث تواصل جغرافي بين سوريا والعراق، وإمّا التضيق على أنشطته المستقبلية، وإمّا رداً على عمليات المقاومة الشعبية التي تستهدف القواعد الأميركية ومقارّ ميليشيا “قسد”.
الجرح النازف
ولا يخرج الجنوب السوري عن سياق الأحداث الجديدة. فالمنطقة، التي كانت تخضع سابقاً لعمليات غرفة الموك الأميركية في الأردن قبل حلها، تعيش اليوم على وقع أحداث أمنية، مبرراتها أبعد من مجرد وجود خلايا مسلحة لا تزال ترفض إلقاء السلاح والدخول في طريق المصالحة، كما هي الحال في بعض مناطق محافظة درعا، أو تدّعي محاولة إشغال الفراغ الأمني القائم، كما يحدث في السويداء اليوم. فما يحضّر من سيناريوهات للجنوب، يكاد يكون أبعد من مجرد استهداف بعض النقاط العسكرية والموظفين الحكوميين، إذ إن عودة الحديث الغربي عن انتشار كثيف للقوات الإيرانية في الجنوب، والتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين العرب والغربيين بشأن سبل مواجهة الوجود الإيراني في سوريا، وتحديداً في تلك المنطقة، تؤكد أن هناك مخططاً ما يجري نقاشه ومقاربته بصورة عميقة في أوساط دوائر القرار الغربي، وربما الإقليمي أيضاً، هدفه مواجهة ما يعدّونه نفوذاً إيرانياً خطراً. ومن دون شكّ، فإن اليد الطولى هي لواشنطن في صياغة ذلك المخطط أو الموافقة عليه. وللعلم، فإن أغلبية وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية كانت تتحدث، قبل الحرب الأوكرانية، عن تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وعن وجود خلافات بدأت تدبّ بين الحليفين الأساسيين في المنطقة. فما الذي حدث حتى انقلبت الآية؟
ليس وحده المتغير الميداني هو الذي يدلّ على ملامح خطة غربية لتصعيد الأوضاع في الساحة السورية. فالأجواء السياسية التي تشكَّلت في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، وما تبع تلك الإجراءات من قرارات وتوجهات اقتصادية، تعكس بوضوح أن الغرب، في أفضل الأحوال والتوقعات، يريد لجرح الأزمة السورية أن يستمر في النزف، تماماً كحال المريض الذي يُصاب بطلق ناري فيُترَك حتى يموت، أو يُسعَف عند التأكد من أن إصابته سوف تتسبب له بإعاقة طويلة.
الميادين نت