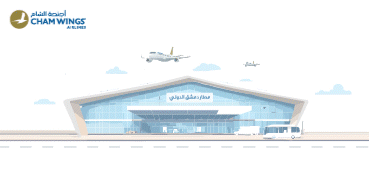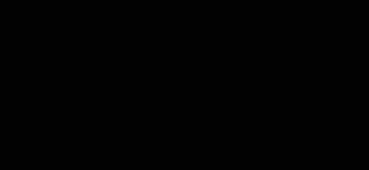كنتُ أكادُ أنهي روايتي الخامسة، ولم أضعْ لها عنواناً، بعد…
حِرتُ، وأنا أقترحُ على داتي، بعضَ العناوين، التي لم تقنعني…
لكنني، وبعدَ تأكدي من رحيلكِ، وإلى الأبد…..
سأسميها (صَوتُ مَحجوبَة )..
للتو، نشرتُ هده المُحادثة، على صفحتي على الفيس، وعلى صفحة مجموعتي (صَلاةٌ.. لغيومكِ القادمة )..
محادثة، للتو، مع المهندس الغالي الأستاد Jamal Hussien
___________________________________________
كل عام ,أنت وأسرتك الغالية ومن تحب، بصحة وعافية وسلامة وأماااان….. يا أحد من أتشرف أن يكون من ضمن أبنائي الروحيين..
شكرا جزيلا لك يا اختي العزيزة و اديبتنا الرائعة
دمتم بصحة و عافية ..انت و من تحبين …
ملاحظة ..تاريخ الميلاد في الفيس عشوائي …
أنا من مواليد 14/10/1953م
انا 21/9/1978
عرفت أنك إبني..؟؟؟؟؟؟
ولي الفخر
أللهيحميكم
الله يحميكم ويوفقكم
تسلمي الي الفخر …
فيك تتابع (صوت محجوبة )؟؟
والا ، بس خلصها ببعت لك اياها؟
هذه صورة لي من العمل الحالي في الجزاءر
وبدي نقد بمنتهى الصدق والحرية.. كعادتك
طبعا يا ريت تبعتيها
لم تكتمل بعد
لكنني أنشر حلقاتها
انهيت مؤخرا قراءة لكاتب جزاءري و للراحل سعد الله ونوس
ألله يعطيك الصحة
رائع
لا اخفيك ان المتابعة ع النت و ع الموبايل ليست جيدة ..
و لكني ان شاء الله ساتبع ما امكن
صحيح
حين أنهيها، سأرسلها لك، ولأمثالك.. تطبعونها وتحتفظون بها بعد قراءتها
هده الكتب، هي أبنائي وبناتي
حافظوا على إخوتكم وأخواتكم، أيها الشرفاء
إنهم يشبهونكم
طبعت كل نا ارسلتيه لي
هل تسمح لي بنشر هده المحادثة؟
و اخذتهم معي الي سوريا عندما سافرت في اجازة …و هم في مكتبتي في البيت
كم يشرفني دلك……!!
كما اني انتظر نتيجة منشور سابق لك موجه لوزارة الثقافة بخصوص النشر …
طيب
طبعا لا مانع
تسلم
وباسمك؟؟؟؟
كما تريدين
وكنتُ قد أرسلتُ شكوي، بواسطة الفاكس، للسيد وزير الثقافة الجديد، وهاهي :
( بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة وزير الثقافة المحترم، الأستاد محمد الأحمد..
تحية طيبة..
تفاءلتُ جداً، عندما سمعتُ أنكَ عُينتَ في هدا المنصب الهام، لثقتي بنزاهتك..
ألف مبارك.. وأعانكَ اللهُ على أداءِ هدة المَهمة الجليلة، وجعل لكَ بطانةً صالحة..
أخي.. لن أطيلَ عليك..
لي شكوى ، ملخصُها، أنني شاعرة وكاتبة عربية سورية، أنشر مند عام 2001م، والعام الماضي 2015م أصبحتُ عضواً مُشاركاً في في اتحاد الكتاب العرب، بعد تقديم ثلاث طلبات، وبنفس الشروط..
عمري 63 سنة..
المُلخص، أن الوزارة لم تقبل أن تنشر لي كتبي، لا لسببِ معقول، إنما لأن (القارئ ) لم يقبل نشرها.. علماً أنني أنشرها على مواقع التواصُل الإجتماعي، وتصلني الكثيرُ من رسائل القراء، بإعجابهم البالغ بها، وهم من مختلف الفئات العمرية، والدرجات الثقافية، والمناطق الجفرافية..
مرةً، قلت لي إحدى الموظفات في وزارة الثقافة ، أن مَن يدفع ينشرون له..!
فسحبتُ روايتي الثالثة (نبضُ الُجدور ) من الوزارة، ونشرتها، على حسابي، خارج الوطن، ولاقتْ إعجاباً كبيراً، ومن المُعجَبين جداً بها (المخرج باسل الخطيب ) الدي وَعَدني، أنه سيحولها إلى فيلم..
أنفقتُ كل ما أملك، على طباعةِ كتبي على حسابيَ الخاص..
لي أربع روايات مطبوعة، ومجموعة شعرية واحدة.. وأكاد أنهي روايتي الخامسة..
1- (صلاةٌ.. لغيومكِ القادمة ) رواية بطبعتين..
2- (مجنونةُ الخصيبة ) رواية
3- (نبضُ الجُدور ) رواية
4- (إلى اللقاء يا أمي ) رواية، كتبَ حولها الشاعر العربي خالد أبو خالد ،الدي اعتبَرَها أهَم من رواية (باولا ) للكاتبة التشيلية العالمية (إيزابيل ألليندي ) واقترَحَ أن تصدرَ ككتابٍ مُلحقٍ لمجلةِ المعرفة، لكن د. علي القيم وجَدَها طويلة، فحَولَها للهيئة العامة السورية للكتاب ، وقال لي أن الموافقة عليها، فقط، مسألة وقت..
وبعد عدة اتصالات مع الأستاد توفيق أحمد ، أخبروني أنها رُفِضت…!!
نشرتُها على مواقع التواصُل، وأهديتُ كل كتبي المطبوعة والإلكترونية لكل من يريد.. وكما قلت، تلاقي إعجاباً كبيراً..
الآن، أعيشُ مع زوجي موجه تاريخ متقاعد ، راتبه حوالي (31 ) ألف ليرة سورية، نعمل بالأرض، ويدعمنا أقاربي في المغترَب..
أضعُ شكوايَ بين يديك، يا سيادة الوزير المحترم.. طالبةً حَقي من هدا الوطن الأغلى، الدي لم أقصر بحقهِ، يوماً، كما لم يقصر بدلك، آبائي وأجدادي، وأسلافي..
حَق من لها حق، ليس إلا..
واثقةً أنكَ ستجدُ ليَ الحَل..
___________________________________________________
عنواني :
طرطوس/ الشيخ بدر/ المريقب
هاتفي الأرضي :….
الخلَوي : ….
وشكراً من القلب، سيادة الوزير
أختك فاطمة صالح صالح
المريقب في 19/7/2016م)
___________________________________________________
بالأمس، جاءني اتصال من دمشق، كانت (ياسمين ناصر ) تخبرني، أنها من (هيئة النشر) أو (قسم النشر) أو.. المهم، أنها موظفة تعمل في وزارة الثقافة، أخبرتني أنهم قدموا للسيد الوزير، التقارير، عن رفضِ القراء الثلاثة، لنشر روايتي (إلى اللقاء يا أمي ) على حساب الوزارة.. وأن تفاصيل القرار، سُلمت للسيد الوزير، وهي بين يديه، الآن..
سأعود لما بدأتُ بهِ روايتي هده، قبل رحيلكِ…
____
على قِمّةِ الجبلِ الذي سُمّيَ باسمِها، وفي /25/10/2007م
جَلَسْتُ أتأمّل..
كانت بيوتُها تتناثَرُ ، تارةً، على التلال المُحيطةِ بها، أو تنخفضُ قليلاً، لتُجاوِرَ وِديانَها الثلاث.. جِهَةَ الشِّمالِ، والجنوبِ، والشرق.. نحْوَ (المْسيل) الذي تسيلُ فيهِ المياهُ شِتاءً، لتُشكّلَ نهراً صغيراً، ضاجّاً، صاخِباً، تهدرُ فيهِ المياهُ في موسِمِ المَطَرِ الغزير.. وتُسَقسِقُ، سابِحَةً فوقَ البلاطِ الأبيضِ، الذي تنعكِسُ فيهِ أشِعّةُ الشّمْسِ، حينَ تظهَرُ من خلالِ الغيوم.. كما تترَقرَقُ تلكَ المياهُ، مُنسابَةً بينَ الصّخورِ الكبيرةِ، والصغيرة، حينَ يهدأ المَطَرُ، أو تخفّ نسبَةُ هُطولِه..
يبدأ ذلكَ السَّيلُ جَرَيانَهُ مع القرية من جهةِ الشِّمال.. مُنساباً من تحتِ قِمّةِ الجَبَلِ بعَشراتِ الأمتار.. ليَعْبرَ الطريقَ العامّةَ التي تصِلُ القريةَ (بالشيخ بدر) مَركز المنطقة.. وقد بُنيَ جِسْرٌ صغيرٌ في ذلكَ المَعْبَر، يسمَحُ بمُرورِ المياهِ تحتَ الطريقِ الإسفلتيّ، عابراً أسطوانتينِ منَ الإسمنت.. كثيراً ما تفيضُ المياهُ فوقَهُما في مواسِمِ الهَطْلِ الغزيرةِ جداً.. يتّصِلُ ذلكَ السَّيْلُ بمَحَطّةٍ تقعُ في أسفَلِ السّفحِ الذي تترَبّعُ عليهِ (المْرَيقِب) القديمة، في مَعْبَرٍ آخرَ يُسَمّى (المْغَيْسِل)، ليَصِلَ بَعدَهُ إلى (الغَبّيط) الذي يسبَحُ فيهِ الرُّعاة.. وما يزالُ الناسُ يتحَدّثونَ عن ذلكَ الشّابِّ،وَحيدَ أمّه، الذي
غَرِقَ فيهِ منذُ عَشراتِ السّنين.. وبَكَتْهُ أمُّهُ حتى نَضَحَ الحَجَرُ دَماً، وهي تقول لجارتها التي تواسيها، قائلة: (سلامة راسك يا أم محمود ).. فأجابتها– وكأنّها لا ترَى أيَّةَ كَلمةٍ قادرَةً على تعزيَتها-: (ولِكْ ألله يكسُر راسى وراسِك)..!!
يَنحَدِرُ ذلكَ (المْسيل) عابراً الصخور، والمَفازاتِ، حتى يَتّصِلَ بالنهرِ القادِمِ من يَنابيعِ جبال (وادي العيون) المُتَعَدّدَة، والغزيرة.. التي تتجَمّعُ، صيفاً، وشِتاءً، لتُشَكِّلَ (نهر البَلّوطَة) الذي يتّجِهُ من الشرقِ، إلى الغربِ، ليَصبّ في (البحرِ الأبيضِ المُتوَسّط) شِمالَ مَدينة (طرطوس)..
عِدّةُ طُرقاتٍ، صارَتْ تتخَلّلُ قريتي.. كانت – في طفولتي، تقتصِرُ على (الزاروب) وهوَ الشارِعُ الرّئيسيُّ فيها.. لم يكنُ عَرضُهُ يتجاوَزُ الأربعةَ أمتار.. تتوَزّعُ حَولَهُ بيوتُ القريةِ الطينيةِ المُتلاصِقَة.. وقَدْ ثُبِّتَ (جرْنُ) الضّيعَةِ الحَجَريِّ الرّمارديّ، مُلاصِقاً لحائط (بيت العَجي) لتدُقَّ فيهِ نساءُ القريةِ كُلّها، القَمْحَ المُبَلّلَ، ب (المِدَقِّ ) الحَجَريّ، المَنحوتِ من نفسِ الصخرةِ البُركانية، في مَوْسِمِ (البرْبارَة) أو، عندما تريدُ المرأةُ أن تطبخَ (القَمْحيّة) في الشتاء.. أو تطبُخَ القَمْحَ المَقشورَ معَ (الحمّص) وتضيف إليهِ (العيران) تمزجهُ
جيّداً، ليصيرَ (مْتَبّلة).. كما يُدَقُّ فيهِ (السّمّاق) عندما تجمَعُ المرأةُ (اللوفَ) منَ الحقولِ البعيدةِ، لتطبُخَ منهُ (طَنجَرَة) للعائلة.. كما تُدَقُّ فيهِ أوراقُ (الرّيحان) الآس، الذي كانتْ أجسادُ الأطفالِ تُدْهَنُ بهِ – بَعْدَ (تنخيلِهِ) – وإضافةِ قليلاً من زيتِ الزيتون لهُ – في الأيامِ الأولى للوِلادة..
كانَ هناكَ (زاروبٌ) فَرْعيٌّ صغيرٌ، يتخَلّلُ (بيت العَجي) و (بيت صالح ديبة) أو (صالح ابراهيم علي حسين).. يتّجِهُ نحوَ الشّمال، حوالي عشرة أمتار، أو أكثرَ قليلاً.. ليوصِلَ القاصِدَ إلى (بئرِ الضّيعة)..
وطريقٌ يهبطُ من خَلْفِ (بيت الشيخ سليمان) جنوباً، وُصولاً إلى (بيت جدّي عبّاس) ويتّجِهُ شَرقاً، عابِراً (بيت محمّد عباس) واصِلاً (بَيْدَر الضّيعة).. يتقاطعُ من تحت (بيت علي ابراهيم) و (مْصيف بيت حَبيب) صاعِداً شمالاً نحوَ (الدّوّارَة) التي تقابلُ (بيت أهلي) و (بيت ابراهيم) في منتصَفِ القرية.. وعلى ذلكَ المُفتَرَقِ الذي يَصِلُ (الدّوّارَةَ) ب (الزاروبِ) بالطريقِ الهابطِ نحو (البَيْدَر).. ما زلتُ أذكُرُ تلكَ الصّخرة السوداء المَلساء قليلاً، والتي كانت تتشبّثُ بالأرضِ، تشبُّثَ أهل قريتي بها، وبقيَمِهمُ الإنسانية الراسخة.. كان الصغار (يتزحلطون) عليها، أمام أعين الأمهات الكبيرات، عجائز القرية، الجَدّات، اللائي تعوّدنا أن نُنادي كلَ واحدةٍ منهن (ستّي) لأنها بنظرنا ونظر أهلنا، سيّدتنا، خُلاصَة تجارِبِ الأجيال، المَرجع الأهمّ.. معترفينَ بقيمَتهنّ.. مُقدّرينَ تضحياتِهِنّ، وما يحملنَ من تراثٍ، على كل جيلٍ أن يبني عليه، ويطمئنّ إلى رسوخِ جذوره..
كُنّ يجلسنَ في ظلالِ البيوتِ الطينيّةِ، حينَ تميلُ الشمسُ نحو الغروب.. بثيابهِنّ التراثيّةِ الجميلة.. فساتين قطنية واسعة مُشجّرَة، تزنّرُها (زنانيرُ) قماشيّةٌ بعَرضِ راحَةِ الكَفّ، تعقِدُها المرأةُ على أحَدِ جانبَيّ خَصْرِها.. وقد تربطُ فيها بعضَ قِطَعِ النقود المعدنيّة.. الأكمامُ طويلة.. والقَبّةُ مُدَوّرَة، تصِلُها من تحتِ العنقِ، إلى تحت الزنّارِ على الصَّدرِ عِدّةُ (كبّاسات) أو أزرار.. تُتيحُ للمرأةِ إرضاعَ أطفالِها بسهولة.. أو أنّ تدسَّ في (عُبّها) بعضَ (التّينِ المُهَبّل) عندما تذهبُ إلى جَلْبِ (الحَشيشِ) أو الرّعي، أو قطعِ الحَطَبِ من الوِديانِ البَعيدةِ (ويدي وِهْبانْ)، أو القريبة.. لتحملهُ على رأسِها، ربّما قبلَ بزوغِ الفجْر.. وقد لا تطلعُ الشمسُ، إلاّ وتكونُ المرأةُ قد قطَعَتْ، ونقَلَتْ أربعَ (حَمْلاتٍ) منَ الحَطَبِ، منَ الوادي، إلى جوارِ البيت..
أو بعضَ الخُبْزِ، والعِنَبِ.. عندما تُرافِقُ زوجَها، وهوَ يصطَحِبُ الثيرانَ إلى الحقولِ للحِراثةِ التي قد تمتدُّ من قبْلِ الفجْرِ، إلى ما بَعْدَ المَغيب (لَمّة الضّوّ)..
تحتَ الفساتينِ، تأتي (القُمصانُ) القطنيّةُ الرّقيقةِ، المُعَرَّقَةُ بعُروقٍ ناعِمَة.. واسِعَةٌ، أيضاً.. مزمومةٌ من الخصْرِ، أو ذات طَيّاتٍ مُسَطّرَة.. ولها (جَيباتٌ) قد تحملُ فيها المرأةُ بَعْضَ حَبّاتِ (الزّبيب) لتتناوَلَها أثناءَ العَمَلِ بالأرضِ.. أو تُطْعِمَها للأطفال.. أو.. ربما تحملُ فيها المرأةُ (مَحرمة) عبارةً عن قِطعَةِ قماشٍ صغيرةٍ، اقتطَعَتْها من ثوبٍ قديم.. تستعمِلُها لمَسْحِ عَرَقِها، أو تجفيفِ أنفِها، أو دموعِها.. أثناءَ هُبوبِ الرّياحِ البارِدَة..
تلي ذلكَ (اللبّيس).. وهي عبارة عن سراويلَ قطنيّةٍ مُشَجَّرَةٍ، أيضاً.. يغلبُ عليها اللونُ الأحمر.. كانتِ الجَدّاتُ الكبيراتُ يَجْمَعْنَ طَرَفَيها بقطعتينِ من المَطّاط، مَنعاً من ارتفاعِها عنِ الكاحِلَينِ أثناءَ العَمَل.. أما بناتهُنّ (عمّاتي، وأترابهُنّ) فقدِ استبدَلنَ المطّاط، بكَشاكِشَ في أسفلِ كلّ ساقِ من ساقيّ السروال، وضَيّقْنَ فَردَتيهِ أيضاً.. لكن، مع مُراعاةِ السّعَة، التي تبدأ من الرّكبَتَينِ، حتى الخصْر، الذي يُثبّتُهُ المَطّاط فوقه..
أما غطاء الرأس.. فقد كانتِ الجَدّاتُ تلبَسْنَ فوقَ (البوشيّة) وهي عبارة عن غطاء دائريّ قماشيّ سميك أسود، قد تلمَعُ فيهِ بَعضُ خيوطِ القصَبِ الفضّيّةِ، أو الذّهَبيّة.. يحيطُ بالرأسِ حتى فوقَ الأذنين.. تليهِ (شوراية) قماشيّة قطنيّة بيضاء، مُرَبّعَة الشكل، تُلَفُّ كالكعكةِ فوق البوشيّة.. أو تُطوى بشكلِ مُثلّثٍ، ويُرْبَطُ طَرَفاها من الأمام، تحتَ الذّقن..
كثيراً ما كانتِ النساءُ، والرجالُ، والأطفالُ، حُفاةً.. أو ينتعِلون أحذيَةً من (الغوما) كانتْ بعضُ النسوةِ يخلعنها وهُنّ صاعداتٍ من الوادي، إلى القرية، يحملنَ على رؤوسهنّ (حَمْلاتِ) الحطَبِ، أو (الحْماية) ويضعنَ الحذاءَ داخِلَ (الحَمْلةِ) التي يلفّها (خْناق) مصنوع من شَعْرِ الماعز، ويُكْمِلنَ الدّرْبَ الضّيّقَ المليء بالحَصى والتراب، حُفاةً.. حتى يصلنَ إلى بيوتهنّ على ارتفاعِ عِدّةِ كيلومترات.. كي لا (يخيس) أو (يخرب) الحذاء، أو (المْداس) أو (الصّرماية).. هذا الأمر، ظلّ حتى خمسينات القرن العشرين، على الأقَلّ..
في حوالي منتصف العشرينات، من القرن العشرين، خَلَتِ المنطقة من الحروبِ المُباشِرة، وهُمِّشَتْ (المْرَيْقِب) مثلها مثل أغلبِ القرى، مع أنها كانتْ تعجُّ بالحياةِ، أثناءَ الثورةِ التي انطلَقَتْ منها الشّرارِةُ الأولى ضدّ الغُزاةِ الفرَنسيّين، في خريفِ عام/1918/م.. وأُخْمِدَتْ عام /1921/م..
كانتْ (المْرَيقِب) أثناءَها، مَحَطّ أنظارِ، واهتمامِ القوى الداخليّةِ، والخارِجيّة.. فهيَ مَسقطُ رأسِ قائِدِ الثورة، الشيخ المُجاهِد، ورَجُلِ الدّينِ الوَرِع (الشيخ صالح العلي) والكثير من الثوّار، منذُ العَهْدِ العُثمانيّ البَغيض.. ومن أهَمِّهِم – إن لم يكنْ أهَمّهم – أجدادي، وجَدّاتي.. وعلى رأسهم جَدّي لأبي، المُجاهِد البطل العنيد الشجاع (الشيخ سليم صالح) الذي عَيّنَهُ قائدُ الثورة، (عَقيداً) فيها..
______________________________________________
في منتصف الخمسينات من القرن العشرين،
لاحظت الأم أن بتول، ذات الأعوام الثلاث، تترنح في سيرها، فأوقفتها :
-إلى أين يا بتول..؟
-إلى عند ذكية..
-قفي.. قفي لحظة، يا ابنتي..
وكشفت لها عن بطنها.. كان مليئا بالبقع الحمراء الصغيرة..
أرخت فستان الطفلة، وهي تضحك بقلق خفيف :
-لا والله، لن تذهبي يا بتول.. اليوم بقاء في البيت.. ذكية.. لن تزوريها منذ الآن، إلى.. وتلمّست جبين الطفلةِ، و وَجهها، الذي كان كالجمرة الحمراء..
تابعت الأم :
-عودي يا بتول.. عودي، يا ابنتي، ونامي بين إخوتك، حول المدفأة..
بكت الطفلة، معترضة على منع أمها لها من زيارة ابنة الجيران، الذين كانوا قد أحضروا منذ مدة قصيرة، جهاز راديو، وضعوه في الغرفة الطينية، ومَدّوا له (أنتيناً) معدنياً على السطح، وثبّتوه بقليل من الطين، والحجارة..
كانت الأم تعجز أحياناً عن إقناع ابنتها بعمل شيء ما، إن لم تقدم لها إغراءات كثيرة.. كأن تعمل لها (عضوضة) زيت وسكّر.. أو تسمح لها باللعب بالطين.. وإن استعصى عليها إقناعها، كانت تلجأ إلى إغرائها بأكثر الأشياء رغبةً عندها :
-أضعكِ في راديو بيت (أحمد عزيز)..
فتسرع الطفلة بإنجاز كل ما تطلبه منها أمها، أمَلاً بتحقيق حلمها الأكبر.. وهو الدخول في جهاز الراديو، الذي كان يُدهشها كثيراً خروجُ أصوات النساء والرجال منه، وتنشغل أكثر في التفكير : – كيف يدخل هؤلاء البشر إلى هذا الصندوق..؟! لكنها اقتنعتْ أخيراً، أنّ أجسادهم تتقلّصُ وتصغر بالتدريج، وتتضاءلُ، حتى تصبح على مقاسٍ يمكّنها من الدخول في الراديو من الخلف، وتبادُل الأحاديث، والغناء.. إلى آخر ماهنالك مما تسمع..
لكنها عجزتْ عن إقناع أمها هذه المرة، بالسماح لها بزيارةِ ذكية، بنت (أحمد عزيز).. فقد تأكّدتِ الأم أنّ ابنتَها أصيبتْ ب (الجرْشِة).. وأنّ عليها أن تنام قرب المدفأة الحديدية الأسطوانية، التي يتوَقّدُ فيها حَطَبُ السنديان، والبَلّوطِ، وجذور الآس..
كانت ماري قد حَمَلَتْ أبناءها وبناتها، واحداً واحِداً، وصعدت بهم الطريق الترابية، التي تصل القرية بحارةٍ، تبعد عنها أكثر من نصف كيلومتر، لتنيّمَ الأطفال بين أترابهم من الأقارب الذين سبقوهم إلى العدوى بهذا المرض الذي يبقى هَمّاً على الأهل توقّعُ إصابة أبنائهم به.. وكانوا متأكّدين أنّ أيّ طفل سيتعرّضُ للإصابة به.. كما في (الشاهوق) وغيره من الأمراض التي لا مندوحة عنها، وليس لها أيّ دواءٍ، إلاّ رحمَةُ الله..
– أراكِ تضحكينَ..!!
– إي والله، أضحك..
– أعرف لمادا.. لكن..
– لكن، لمادا لا تسمي الناس بأسمائهم الحقيقية..؟!
– لكي لا أسيءَ إلى أحد..
– لكنني عرفتُ مَن هيَ ماري، و… و..
– أرجوكِ، يا أمي.. أنا أعرف أنكِ تعرفين، لكن، ألم تطلبي مني تغييرَ الأسماءِ الحقيقيةِ في (نبض الجدور ) ولنفسِ السبب..؟!
– صحيح
– وعُدتِ، وسألتني أكثر من مرة، وأنتِ تعيدين قراءتها، لمادا غيرتُ الأسماء، فأجيبكِ، أنني فعلتُ دلك، بطلبٍ منكِ، ولنفسِ السبب..
– ألله يعطيكِ العافية، يا ابنتي.. أكمِلي توثيقك، برعايةِ اللهِ وحِفظه..
– ألله يسعدك، حيثُ أنتِ، يا أميَ الغالية..
______________________________________________
هناكَ، في الأعماق، تبدو بيوتٌ ثلاثةٌ، مُتجاوِرة، وآخرُ قريبٌ من قِمةِ الجبَل..
(بيت الشرقي) و (بيت الوسطاني) و (بيت الغربي ) لأجدادي الثلاثة (الشيخ محمد صالح) و (الشيخ علي صالح ) و (الشيخ سليمان صالح ) والبيت الرابع لجَدي (الشيخ سليم صالح ) وهوَ أصغرُ إخوته الكور.. ولهم أختٌ كان اسمُها (آمنة ) وهي (ستي أم علي ) أو (أم علي آمنة ) وقدِ اغترَبَتْ مع زوجِها إلى الأرجنتين، وعادتْ، ومعها حفيدُها (زكريا ) الدي كان في مثل عمري، تقريباً، وقد تعلمَ معنا في المرحلة الإبتدائية..
وبيتٌ آخرُ، أحاوِلُ أن أتصورَه، فأظنُ أنه في حارةِ (القَلع ) أو قرب (الروَيْسِة ) وهوَ بيت (الشيخ غانم سلمان ) أبو جَدتي (خديجة ) أم أمي..
_______أعلى النهايأسفل النموذج
أذكرُ من طفولتي الباكرة، أنّ أبي أمسَكَني من تحتِ إبطي، وسارَ بي عدّةَ خطواتِ، حتى أوصلَني إلى أمامِ الرجلِ الذي أرسِلَ من قِبَلِ الدولةِ، ليلقّحَ أطفال قريتنا، ضدّ مرَضِ الجُدري، وكان أهلُ القريةِ يُسارعون إلى إحضارِ أطفالهم، إلى (بيت ستّي أم عباس ) وينتظرُ كلٌّ دَورهُ.. لم يكترثْ أبي كثيراً إلى صراخي، خوفاً من الحُقنة، ليس هناكَ مَجالٌ للدّلالِ، وهيَ فرصةٌ تحصلُ كلّ عامٍ، أو أكثر..
وما تزالُ تلكَ الندبة، في زنديَ الأيسر، والتي هي عبارة عن حبّةِ جدري، شُفِيَت من تلقاءِ نفسها.. ومنعت عني ذلك المرضَ اللعين..
إشراقةُ روح
تبدأ الشمسُ فَرْدَ جدائلِها على سفوحِ التلالِ، وقِمَمِ الجبالِ الخضراءِ، التي بدأتْ أصابعُ الربيعِ تهزُّ عَطاءَها من كتفيه، فتخضرُّ روحُها، وتمشي إلى حيثُ خُلِقتْ له.. ينسابُ النورُ على صفحاتِ روحِها، وعلى شُرفةِ منزلها المتداعية.. أشعةٌ ناعمةٌ تولَدُ هذا الصباح، ذهَبيةٌ، كأنها بدايةُ نضوجِ سنابلِ القمح.. ترفرفُ أجنحةُ الكينا، وتصفقُ وهيَ تستقبلُ الشمسَ، كأنّ أوراقها لآلئُ ترقصُ في روحِ أنثى عاشقة..
قبل طلوعِ الشمسِ، نهضت (محجوبة)، قاوَمَتْ إغراءَ النومِ قليلاً، وخرجت إلى شُرفةِ الفجرِ، تلتقطُ من سِحرهِ أنفاسَها الرطبة.. تنفست بعمقٍ، عدّةَ مرات.. عَبّتْ كلّ ما تستطيعُ من رحيق.. وزفرَتهُ غنياً بالكربون.. انتعَشتْ أورِدَتها، وشعرت بالمزيدِ من النشاطِ يُنعِشُ روحَها، راحتْ ترفرِفُ بأجنحتِها الخمسينيةِ، كأنها ابنةُ عشرين، رقصَتْ ملامِحُ وجهِها الأسمرِ، كأنها سنابلُ حنطةٍ يؤرجِحُها نسيمُ الفجرِ الأخضر، فتلوِّحُ لهُ بسُمرَتِها الناضجة..
ذهبَ الفجرُ إلى شُرفةٍ أخرى في هذا العالم، وانسالَ الشعاعُ الذهبيُّ على أسطحِ المنازلِ البعيدةِ والقريبةِ، في مُحيطِ (مَحجوبَة)، لم تأبه كثيراً للمدّةِ الزمنيةِ التي استغرقها مسيرُها الباكِرِ، من أقصى غربِ الشرفةِ، إلى أقصى شمالها.. لم تأبهْ لبلوغِها الخامسة والخمسين، قبلَ عدّةِ أيام.. لابُدّ أنهُ أصبَحَ لحياتِها مَعنى.. لا بُدّ أنّ وجودَها صارتْ لهُ قيمةٌ مُجدِية في هذه الحياة.
لوحاتُها، التي تحرصُ على التوقيعِ عليها باسمِها (الجميل)، مَركونةٌ في زوايا منزلِها البعيد، تحثّها على الإستمرار، تدفعُها دائماً إلى الأمام.. الأمام..؟! أم..؟! وهل هناكَ أمامٌ وخلفٌ، حينَ تكونُ الحياةُ مُفعَمةً بالعطاء..؟!
كلُّ لوحاتِها، كانت مُستوحاةً من وجهِ صغيرِها (صَباح) الذي رحَلَ، دونَ أن يكونَ لها سَنَداً على الحياة، بل أضافَ إلى أعبائها أعباءً مُضاعَفة..
تقفزُ إحدى لوحاتِها من مكانِها، وتجلسُ القرفصاءَ أمامَ مُبدِعَتِها، كأنها طفلةٌ تداعبُ أمها، وتُبادِلُها الفرح.. تمسحُ (محجوبة) على شعرِ الطفلةِ، وتضمّ رأسَها، وتمنحُها قُبلةً صباحيةً دافئة..
آذارُ يحضنُ الكونَ، ويحضنُ روحَ (مَحجوبَة).. تشعرُ بحنانِهِ الذي رافقَها منذُ أن وَجدَتْ ذاتَها.. تمتلئُ بالنشاطِ، والهِمّة.. وتبدأ العَمَل.
إنها تعرفُ قيمةَ حياتِها، الآن، وقيمةَ عَمَلِها، وتدركُ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، معنى أن تكونَ إنسانة، ومعنى أن ترسمَ طريقَ حياتِها، كما تريد هيَ، وكما يُسعِدها.. كيفَ تتأقلمُ مع ظروفِ حياتِها، مهما كانت قاسية.. وقد أفلحَتْ في تحويلِ ماهوَ سلبيّ، إلى إيجابيّ، كما تراه. وهل تنضجُ السنابلُ، إلاّ بعدَ أن يمرَّ عليها فَصلٌ منَ الحرارةِ الشديدة..؟!!
منذ سنوات، كانت (محجوبة) قد استيقظتْ من كوابيسِها، لتسألَ نفسَها :
مَن أنا..؟!
أين كنتُ قبلَ قليل..؟!
أين زوجي مُعتزّ..؟!
وهل أنا متزوّجة، حقاً..؟!
أين تالة، وهالة، ابنتيّ..؟!
أين قبر طفليَ المسكين، صباح..؟!
وكيف تكون لي ابنتان، دون أن أكون متزوّجة..؟!
وهل هذا بيتي، حقاً..؟!
وماذا يمتلكُ من مُقوِّمات البيت..؟!
الجدران الإسمنتية.؟ والسقف.؟ والغرف الواسعة.؟ والشرفة، التي تطلُّ على الطبيعة الجميلة..؟!
وهل كلُّ هذا كافٍ لأن يكوِّنَ بيتاً لأسرةٍ كانتْ حُلُمي..؟!
البيتُ وطنٌ صغير..
_______________
أبعَدَتْ عن رأسِها كلّ فكرٍ سلبيّ، يمكنهُ أن يثبّطَ هِمّتها، أو أن يعيدَها إلى نفسِ الدائرةِ المُغلقةِ، التي كانت مَسجونةً فيها، وتدورُ حولَ نفسِها وهُمومِها دونَ قرار، مدّةً تجاوزتِ الثلاثينَ عاماً.. ترَحّمَتْ على طفلها ذي الإحتياجِ الخاص، واقتنعتْ، وهيَ تنظرُ إلى صورتهِ الحبيبة، أنّ عينيهِ الصغيرتين، تحثانِها على المزيدِ من تحقيقِ ذاتِها :
-أكونُ سعيداً، كما تمنيتِ لي، يا أماه، في حالةٍ واحدة.. أن تكوني أنتِ سعيدة….
قبّلتهُ من جبينهِ، ومن خدّيهِ ، ولامَست شعرهُ بأصابعِ أمومتها، وضمتهُ إلى صَدرِها، قبل أن تركنَ الصورةَ في مكانها المُفضّل :
-سأحَقّقُ رغبتكَ، يا بُنيّ.. لكن.. ابقَ معي..
-أنا معكِ، يا أماه….
-أعرفُ يا صغيري.. ولن يهمّني، بعدها، سُخطَ أبيكَ، أو نظرةَ الشفقة، أو الإستخفاف، من أيٍّ أحدٍ في الكون..
ضحكتِ الصورةُ، وانبثقَ النورُ من عينيّ صَباحِها…
تناوَلتِ الريشةَ، والألوان، وبدأت ترسمُ مشاعرَها…..
تناسَتْ أنها لوحدِها…. بل، لم تعُد لوحدِها… صَباحُها يرافقها.. ويساعدُها على إقناعِ أختِهِ هالة، أن تنسى ريمون، وخداعَه… وأن تنهضَ من جديد…
-ريمون، لا يعرفُ إلاّ مَصلحتهُ الخاصة، يا أختي.. ولا تهمهُ مشاعركِ، أو مشاعر كلّ مَن خَدَعَهنّ… ها أنتِ ترين، فقد تزوّجَ من تحققُ لهُ رغبته، ونسيكِ، كما نسيَ كلّ ضحاياه… لا تلوميهِ يا أختي.. فقد ربّاهُ أبواهُ على هذهِ الأنانية..
-لكنني مُحَطّمةٌ يا أخي.. أنا مُحطّمةٌ يا صباح…
-لستِ محطمة.. أنتِ تعاقبينَ نفسَكِ التي صَدّقتْ ريمون، وأضاعتْ من عمرِها سنتين، وهيَ لا ترى سواه.. تركتِ دراستكِ، والتحقتِ بأهوائه.. كنتِ تفاخرينَ أنهُ يغازلكِ أكثر من بقيةِ الفتيات..
-لا تزيديني ألماً، يا أمي.. حتى أنتِ ضدي..؟!
-أنا معكِ، ولستُ ضدكِ، يا هالة.. تبقينَ ابنتي، رغمَ تمرّدكِ، وعنادِك..
-ألم يخدعكِ زوجكِ أنتِ..؟! اعترِفي..!!
-لكنني نهَضتُ، وتابعتُ حياتي بما تبقّى لديّ من طاقة.. وأنتِ ترينَ النتائج..
لم يكنْ لديّ أيّ سلاحٍ أواجهُ بهِ العالمَ، بمُفرَدي.. فاعتمدتُ على مَوهبتي، مِنحَتي الرّبانية.. ولم أسمحْ لأبيكِ، ولا لبقيةِ الأشواكِ المُتألّبةِ، أن تمنعني من تحقيق ذاتي.. أنقذتُ ما يمكنُ إنقاذه… أنتِ مازلتِ في ريعانكِ، يا ابنتي.. قومي… فالحياةُ هديةٌ من القوةِ الخالقة.. ويجبُ علينا أن نملأها بالعطاء، الذي يُغنيها.. كي نرضي الله.. عندها، فقط، نثبتُ أننا نستحقّها..
-مازلتُ في ريعاني..؟! نسيتِ أنني تجاوَزتُ الخامسة والثلاثين..؟؟! نسيتِ أنّ تالة تزوّجتْ مَن أحبها وأحبتهُ، ورُزقت بطِفلين..؟! نسيتِ أنها مدرّسة، وأنا لم أحصل على الشهادةِ الثانوية..؟! هل خرِفتِ..؟!
-لم أخرف، بعدُ، يا هالة…. أعرفُ كلّ ذلك… لكن….
-لكن، ماذا..؟!! ستقولينَ لي : لم يفتِ الأوانُ، ولن يفوتَ، مادمنا على قيدِ الأمل… أنا لا أشعرُ بأيّ أمل.. أنا مَيتة..
-مَن التي تكلّمني، إذاً..؟!
-اضحكي.. اضحكي عليّ، كعادتِك…..
كانَ محمودُ قد عادَ من غُربتهِ، حاصِلاً على شهادةٍ رفيعةٍ، أهّلتهُ لإنشاءِ معملٍ لصناعةِ الألبسةِ الجاهزة، بخِبرَةٍ مُضاعفة.. شجّعهُ على إنشائهِ في مدينتهِ الساحليةِ، تحسّنُ وضعِ الوطنِ، بعد خمسٍ عِجاف.. وبدأتْ براعمُ ربيعِنا الحقيقيّ تلوّحُ للفجرِ الأخضرِ، بعدَ ليلٍ دامِسٍ أحمر.. لم يقدر، خلالَ تلكَ السنواتِ الحارّةِ، أن يحضرَ زفافَ أخوَيهِ الشهيدَين.. لكنهُ قرّرَ أن يثأرَ لهما، على طريقتهِ الخاصّة..
-أعرف.. تظنينَ أنّ محمود، سيقبلُ بي، بعد كلِّ ماحصَل..!!
-لا أظنّ ذلك.. لكنهُ يبحثُ عن عاملات… وقد أخبرتُهُ بوضعِكِ، عندما استفسَرَ عن حالتك..
-تشحذينَ عليّ..؟!
-أكسرُ فمكِ، إن تطاوَلتِ عليّ، بعد الآن…. قومي.. افتحي الباب… ألا تسمعينَ رنينَ الجَرَس…..؟!
___________________________________________
تذكرينَ كم حَدّثتكِ عن محجوبة..!
تذكرينَ معاناتها..؟! وكيف أنكِ كنتِ تستغربين ما تسمعين، إلى درجةِ عدم التصديق، فأقسمُ لكِ.. وتقترحين عليّ أن أوصيها أن تكون واسعةَ الصدر، أكثر، وأن تتحمّلَ المزيد.. وأن تحاولَ بشتّى الوسائلِ، الحفاظَ على حياتِها الزوجيةِ، والتأقلم معها..؟! وأنّ التنازلَ أمام الزوجِ، ليس ضعفاً، بل، هو قوّة، وأنّ عليها المزيدَ من التنازلِ عن حقوقِها..؟!
كم أحتاجُ لأن تكوني بقربيَ الآن، يا أمي..!!
وإذا أردتُ التفكيرَ بعقلي، لابعاطفتي، أشعرُ بالسعادة، أنكِ غِبتِ عن هذا العالمِ الظالم، ولم تشهَدي مايحدثُ في هذا الوطن الأغلى، والمنطقة.. ف (الخيرُ، فيما اختارَهُ الله ) ولا بقاءَ لمَخلوق.
كتبتُ، منذ مدة :
( لو أنكِ لم تغيبي عن عَينَيّ، يا أميَ الغالية.. كنتُ سأقرأ لكِ المزيدَ مِمّا كَتَبتُ، والمزيدَ من الحَكايا.. وبما أنّ روحَكِ خالِدة، أنا متأكّدة أنكِ تسمعينَ صَدى روحي.. سأقرأ يا أمي.. فاسمَعي ما تَبوحُ بهِ روحيَ العاشِقَةُ للخيرِ، حتى الثّمالة.. حَكايا، قد تُصَدّقينَ بَعضَها.. لكنَّ روحَكِ الصافية، سوف لن تستطيعَ تصديقَ بعضِها، لو أنّ غيري يرويها لكِ.. لكنّكِ، وقدِ امتزَجْتِ بالمُطْلَق، اللامَحدود، واللانهائيّ.. تستطيعينَ الرؤيةَ إلى ما لا حَدّ لهُ، ولا مُعيق.. تحَرّرْتِ من قيودِ الجَسَد، وقيودِ المُجتمَعِ الدّنيويّ.. وسكَنتِ اللانهائيّ، الأزليّ السرمَديّ.. عالم الحقِّ المُطْلَق، والجَمالِ المُطلَق.. و بالتأكيد، ستُدرِكينَ الحقائقَ بشكلٍ أجلى، وأوسَع.. فاستَعِدّي يا روحَ أميَ الأغلى، استَعِدّي لتَلَقّي رسائلَ روحي..
أوائل أيار عام 2016م )
لكنني عَدَلتُ عن ذلك، فارقدي بسلام، يا روحَ أميَ الطيبة..
___________________________________________
هيَ التاسعة ودقائق عِدّة، من مساءِ يومِ الخميس، الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012م..
قبل قليل غفوتِ على سريرِكِ في غرفة أبي الشرقية، وعلى سريرٍ كان سابقاً من عَفشِ بيت أخي الغالي اسماعيل، رحمهُما اللهُ تعالى..
قلتِ لي قبلَ أن تغفي:(تكفيني هذهِ اللمسَة.. والله تكفيني..).. (سامحينا يا أمي..) ظناً منكِ أنكِ تُتعِبينني، ياغالية.. قُلتِ.. وقلتِ.. وقلتِ.. بصوتٍ ضعيفٍ.. هوَ الأنينُ، أكثر مما هوَ كلام..
قبّلتُكِ عِدّةَ قبلاتٍ دافئة.. و بقيتُ أمَرِّرُ أصابعي، برِقّةِ روحي، فوقَ خدّيكِ، وجبينك.. وأمسَحُ بهما على شعركِ الناعِم، الذي لم يَشبْ منهُ أكثر من نصفه.. بينما شَعري، وأغلبُ أشعارِ النساء والصبايا، حتى الصغيرات، صارَ – لولا الصِّباغ – كُلّهُ أبيض..
الكهرباء تنقطعُ مدّةً طويلةً، أو قصيرة.. عِدّةَ ساعاتٍ.. أو عِدّةَ دقائق.. ثمّ تأتي.. فأفتحُ التلفازَ لأسمعَ الجديدَ من أخبارِ الوطنِ الأغلى.. ومن أخبارِ غَزّة.. والعالم..
إبنُ أخي الغالي يوقِدُ مِدفأةَ الحطبِ في الصالون الذي أصبحَ غرفتهُ الخاصّةَ، منذُ قرّرنا الإنتقالَ، أنا وأنتِ، من غرفةِ جَدّتي – أوضتنا – إلى غرفةِ أبي.. لنُمضي هذا الشتاءَ الساخِنَ والمُحتقِن.. يدخل حفيدكِ التواليت العادي.. فيسمعني أكلّمك.. ويسمعُ صوتَكِ الأنينَ يعلو بالدّعاءِ، وبالهَذيان – ربما – فيمدُّ رأسَهُ عبرَ العتمةِ، من شقِّ الباب.. ويُشيرُ لي، إن كنتُ أريدُ مُساعَدَة.. فأُومِئُ له، أن.. لا.. ستنام.. فيعودُ إلى غرفتِه.. يفتحُ (الّلابتوب).. يتسَلّى.. ويأخذُ معلوماتٍ عمّا يحدثُ في هذا العالَمِ المُلتهِبِ، والمُضطرِب.. وربما يُغازلُ إحداهُنّ.. أو يُحَمِّلُ مِلَفّاً يحوي مناظرَ أبشعِ أنواعِ القتلِ والتعذيب والهَمَجيّة.. مِن قِبَلِ عِصاباتٍ منَ القَتَلةِ المُحترِفين.. بحَقِّ مجموعةٍ من أفرادِ الجيشِ العربيِّ السوريّ.. أو المواطنينَ الذينَ يُخالِفونهم في العقيدةِ، أو التفكير، أو الإنتماء.. فيشفوا غليلَ أحقادِهِم، ومَكبوتاتهم النفسيّةِ والجَسَديّةِ، بقَتلِهِم وتعذيبِهم.. وهم بأشَدِّ حالاتِ النشوة.. ويقولون : (أللهُ أكبر) و ( سُبحانَ مَنْ حَلَّلَ ذَبحَكم.. ) أو تهاليلَ خاصّةً بهم.. قبلَ أن ينتقِلوا إلى عَدوٍّ آخر.. أو أعداءَ آخرين..
لم أنتبهْ، سوى الآن، إلى أنني أكتبُ على الدفترِ الخاصِّ بكِ.. والذي أحضَرتُهُ من دُكّانِ بيتِ أخي عيسى، بعَشْرِ ليراتٍ سوريّة.. وأحضرتُ آخرَ لي.. كتبتُ على أحدِ الدّفتَرَينِ اسمَكِ الغالي، الذي أحبهُ أكثرَ من كلِّ الأسماءِ يا أمي.. وكتبتُ على الدفترِ الآخرِ اسمي.. على أن تكتبَ كلُّ واحِدَةٍ مِنا ما تريدهُ على دفترها.. في محاولةٍ مني لتسليتِكِ ياغالية.. لتشعري أنكِ تعمَلينَ شيئاً، يُقلِّلُ من شعورِكِ بعَدَمِ الجدوى، والفراغ الذي اعتراكِ بعدَ وفاةِ أبي الغالي، قبلَ أكثر من ثلاث سنوات.. أبَيتِ أن تسمحي لذاكرتِكِ (الميموري) أن تعترفَ بالواقع.. وبأنكِ فقَدْتِ أكبرَ دَعامَةٍ، وأمتَنَها، في حياتِكِ، بعدما تركتِ أبوَيكِ في بلاد المَهجَر..
تسأليننا بين فترةٍ، وأخرى، إن كان أبي يحضر.. وأين ينام.. وتنهَضي لتطبخي له الطعام الذي يحبه.. ولا تهدئين سوى عندما نقول لكِ أنّ (هناء) زوجة أخي عيسى، تطبخ لأبي ما يحبّه من طعام، كما عَلّمتِها.. هو قال لها ذلك.. إلى أن تشفي أنتِ.. فتهدئين قليلاً، وتسألين : أين ينام..؟! فنقول لكِ : في أوضة السطح.. أو في الصالون.. لكنكِ، أحياناً كثيرةً تقولينَ باكيةً : والله كلّه كذب.. كلّه كذبٌ وافتراء.. توفي.. توفي.. إي والله توفي. أعرف.. أعرف.. لكنني لا أريدُ أن أصدّق…… وتحبّينَ زوجي، وتتعلّقينَ به (لأنه يحبّ أبو اسماعيل) وتفشينَ لنا سِرّاً كانَ بينكما.. أنه قال لكِ في أيامه الأخيرة، وهو متأثّرٌ جداً : ( ألله يجعلك تكوني من نصيبي كل جيل بخلق فيه يا ماريّا ).. وتتخيّلينَ أحياناً أنه ينام وحده، ويعيش وحده.. وأنه قد يكونُ بحاجةٍ لأيِّ شيءٍ لكنهُ غير قادر على أن يقول ذلك.. وينفجرُ بُركانُ قهركِ دموعاً ساخنةً حَرّى، على حبيبٍ، شريكِ حياةٍ، زوجٍ، صديق، عشتِ معهُ أكثرَ من ثمانيةٍ وخمسين عاماً.. بالحُلوةِ والمُرّة.. تشارَكتما حياةً كادِحة.. قاسية غالباً.. سعيدةً قليلاً.. لكنها (حياة حافلة).. والآن.. لا شيء سوى الفراغ يا أمي.. لا أحدَ يمكنُ أن يملأ فراغ روحكِ يا أمي، سوى أبي الغالي.. رحمه الله..
(لا أحدَ يروي نشَفانَ قلبي إلاّ أنت ).. هذا ما قُلتِهِ لي بالحَرف، بعد وفاة أبي بأكثر من عام..
الآن، تبرُقُ الدنيا وترعُد.. ربما يهطلُ المَطَرُ قريباً.. سأحاوِلُ أن أُحضِرَ الغسيلَ عنِ الحَبلِ الذي على البرَندَة الغربية، قبلَ أن يبتَلّ، إن لم يكُنْ قد ابتَلّ.. نظرتُ عبرَ نافذةِ المَطبخ، المَطَرُ يهطلُ غزيراً.. هذا مايبدو من لَمَعانِ وُرَيقاتِ شجرةِ التوتِ، واهتزازِها، في دار بيت أخي عيسى، وفوقَ الزاروبِ، ومن خلالِ ضوءِ الشارِعِ يبدو الضبابُ، وخيوطُ المَطَر..
الليلُ الماضي لم ننم خلالَهُ، أنا وأنتِ، حتى لو بضعَ دقائق.. كنتِ تتلوّينَ منَ الألم.. ساقَيكِ، كَعبَيكِ، رأسكِ، خاصِرتكِ حيثُ تستقرّ (بحْصَة) كبيرة في كليتكِ اليسرى.. ظهركِ الذي ظهَرَتْ في أسفلِهِ كتلةٌ تكبرُ بسرعةٍ، ثمّ تصغر.. وتعمّرُ قليلاً.. تحكّينها قليلاً، وتتألّمينَ منها.. لكنّ الغريبَ في الأمرِ أنني عندما أجرّبُ أن أضغطَها بإصبعي، لا تؤلمُك.. منذُ عِدّةِ أشهر ظهَرَتْ، دونَ أن نعرفَ ماهيَ، أو ما سَبَب ظهورِها.. قالَ الدكتور محمد: إنها (خشكريشا )..وقال طبيب الجراحة: قد تكون كيسَ شعرٍ، أو عظماً مكسوراً ناتئاً، أو شحماً.. لا أعرف.. المهم، اعطوها (أوغمانتين) فهو يفيدها على كل حال.. وكان رأي د. محمد، أنّ (الأوغمانتين) يفيدها من الناحية البولية والكتلة.. منذ عشرات السنين، يا أمي، والتهابات المَجاري البولية الشديدة والمُعَنّدَة تتكرّرُ عليكِ، وتؤلِمُكِ أشدّ الإيلام، معَ الحكاك الشديد في المنطقة التناسلية.. لم يشفَ حتى أخذتِ دواءً بوَصفةِ الغالية صديقتي الدكتورة.. ونادِراً جداً ما يتكَرّرُ عليكِ الحكاك.. قال د. محمد عن آلامكِ المُتعَدِّدة والمُتنقِّلة، أنها آلام عظمية وعضَلية.. ولا دواءَ لها سوى المُسَكِّن.. هذا الليل، حتى المُسَكّنات لم تفِدْكِ يا أمي..
ها أنتِ تستيقظينَ بعدَ رقادٍ دامَ حوالي ساعة، من صباح هذا اليوم السبت 24-11-2012م.. ها أنتِ تنادينني لتتأكّدي أنني موجودة.. وعندما أجيبُكِ أنني هنا، قربكِ، بجانبِ المدفأةِ أجلسُ على الديفون قربَ النافذة الشمالية، وألُمسُ قدَمَكِ المُغطّاة بالبطانية الخضراء الناعمة والعريضة، التي كان أبي يتدثّرُ بها.. لكنّكِ تقولين لي : أتمنّى أن نبقى قريبتينِ من بعضِنا.. وأطمئنكِ أنني لن أترككِ وحيدةً يا أمي.. فأنا سَنَدٌ لكِ ما دُمتُ حَيّةً وقادِرَة.. وأنتِ تدعينَ ليَ اللهَ ألاّ يحوجَني إلى أحَد، وأن يعطيني ما أريدُ من خيرِ الدنيا والآخرة.. آمين، يا أمي..
قبل قليل تحرّكتِ في فِراشِك.. رَفَعْتِ يدَكِ اليسرى نحوَ السقفِ كأنكِ تريدينَ شيئاً.. فاغتنمتُ الفرصةَ لأتركَ شربَ المَتّةِ مع أمّ محمد، التي تحكي لي مطوّلاً عنِ الماضي.. تضيفُ إلى معلوماتي.. وأحياناً أشعرُ بالمَلَل.. ومَشيتُ نحوَ سريرِك، لا مَستُ وَجهَك، مَسَحتُ على رأسِكِ، وشعرِكِ الناعم، خدّيكِ الطريَّين، وجبينك، ذقنكِ المُحُدَّبةِ الحلوة.. تثاءَبْتِ عِدّةَ تثاؤباتٍ، تدلُّ على الراحة.. أمّ محمد، وَدَّعَتنا وعادَتْ إلى بيتِها.. سَمعتُ أحَدَهم يُكلِّمُها.. نظرتُ منَ النافذة، بعدَ فَتحِها.. رجُلٌ أربَعينيٌّ على موتور يطلبُ منها إن كانَ بإمكانِها التبَرُّع لإنقاذِ شابٍّ مخطوفٍ من (بْرمّانة المَشايخ).. سألتُهُ : مَن أنت..؟! قال : من برمّانة المشايخ.. أضَفتُ : ومَن هوَ المخطوف..؟! قال : اسمُهُ (وَليد) إبن أختي.. وأضاف : طلَبَ الخاطفونَ مَبلَغاً كبيراً جداً.. فأتيتُ إلى أمين شعبة الحزب أطلبُ المَعونة، فقال لي : ابحثوا أنتم.. أمِّنوا ما تستطيعونَ تأمينهُ منَ المَبلغ، وأنا أرى ما يمكنني أن أساعِدَكم به.. قلتُ له : ألله يفكّ أسرَه.. ويعيدُهُ بخير وسلامة.. هوَ، وكلّ المَخطوفين…………. آآآآآآآآآآآآخ يا أمي.. !! آخ..!! ماذا حَلَّ بهذا البَلَد الأغلى..؟! مَنِ الذي أوصَلَهُ إلى هذهِ الحال..؟! وهل نستحقُّ ما جرى لنا يا أمي..؟! هذا مُستَشهَد.. وذاكَ مَخطوف.. وذاكَ مَفقود.. وآخرونَ مُحتجَزونَ مُحاصَرون من قِبَلِ مُجرِميّ ( الجيش الحُرّ) أو (جبهة النصرة) (القاعِدة).. أو.. أو.. أو.. أو.. وذاكَ يظهرُ من خلالِ صُوَرِ الشهداءِ الذينَ نقلهم حَفيدُكِ عن (الفيسبوك) أو ( اليوتيوب ) وحَفظهم في ملفّاتِهِ على سطحِ مَكتبِ اللابتوب الخاصّ به.. يبدو (مَنهَل) بوجهِهِ الغالي والكادِح.. جثّتُهُ مَرميّةٌ فوقَ جُثثِ عِدّةِ شهداء.. كلُّ واحدٍ منهم في وَضعيّتهِ الأخيرة.. (مَنهَل).. آآآآخ يا خالتو..!! آآخ..!! أيها الكادِحُ الشّريد.. يا مَن كنتَ تبحثُ عن عمَلٍ تستطيعُ القيامَ بهِ لإعالةِ أهلِكَ المُحتاجين.. كنا نشفِقُ عليك، ونحبكَ، لإخلاصِكَ بعَمَلِكَ، ولإتقانِكَ له، ولشهامَتِكَ (يا مَنهَل) لكنني كنتُ أشتُمُكَ مُغتاظةً عندما أسمَعُ هَديرَ موتورِكَ الصغير، وأنتَ تمضي فوقهُ بسرعةٍ فائقةٍ، مُتنقِّلاً من مكانِ عملٍ إلى زيارةِ صديق، إلى بيتِكم البائسِ في (بْرَيصين)..
-عَمّتو.. اليوم تأكّد خبر استشهاد (مَنهَل)..
هذا ما قالهُ لي إبن أخي الغالي، صديقُكَ، والغصّةُ تملأ حَلقَهُ، والقهرُ يهزُّ كَيانَه..
رحِمَكَ اللهُ يا مَنهَل، ورحِمَ جميعَ الشهداءِ الأطهار..
____________________________________________
(فاطمه
الى ابنتي الغاليه مع تقديري لأهتمامها بي
فاطمه)
(سلامٌ عليكم.. شرّفَ اللهُ قدْرَكمْ ودامَتْ عليكمْ نعمةٌ، وسرورُ
فلا تزهرُ الأيامُ إلاّ بقربكمْ وأنتمْ ضِيا عيني اليمين، ونورُ )
هذهِ حصّتي – كنزي، التي نقلتُ محتواها وما كتبتِ على غلافِها، بخطّكِ المُمَيّز، ياغالية..
في أحدِ اللقاءاتِ الصحفية، سألني الصحفيّ :
-لماذا تكتب فاطمة صالح؟
فأجَبتُه : – أكتب، ببساطة، لأنني لا أستطيعُ سوى أن أكتب.
وقد ضحكت (أم ريم ) مُعجَبَةً، عندما أخبَرْتُها بذلك.
روايتي الرابعة (إلى اللقاء يا أمي) قد تصدرُ كَكِتابٍ مُلحَقٍ بمجلةِ (المعرفة) كما اقترَحَ الأستاذ خالد.
المهم أنني (أنجَبتُها ) ولستُ راضيةً عن جَمالِ مَولودَتي إلى حَدٍّ كبير، لكنني متأكّدةً أنها تستحِقُّ أن تُقرأ، وفيها من المتعة والفائدة، ما يجعلني سعيدةً أنني أنجَزتُها خلالَ أكثر من عامٍ بقليل، وأنني كنتُ أشعرُ بآلامِ المَخاضِ، وأرَقِهِ، قبلَ رحيلِ أمي..
كتاب مجلة (المعرفة).. إنجاز ثقافي يتحقق
(بدايةً أرغب أن أنوّه بما عرفتُهُ مؤخراً من أنّ مجلة المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة في سورية، تُطلِقُ مشروعاً جديراً بالإهتمام والإحترام في آنٍ معاً، هو أنها سوف تُصدِر مع كلّ عدد من أعدادها كتاباً مُرفقاً بالمجلة، سيوزعُ مجاناً كما أن المجلة ستوزعُ مجاناً أيضاً، وقد كنتُ أحد المكلّفين بإعدادِ كتابٍ أو أكثر منها، يضمّ إبداعات الشباب أو الأجيال الأعمر، وقد كلّفني بهذا الصديق الدكتور علي القيّم، وهو رئيس تحرير هذه المجلة المحترمة ذات التقاليد العابرة للأجيال والمواكبة، كما أنّ علي القيّم هو واحد من المثقفين في سورية الذي عمل ويعمل على الإسهام في بناء ثقافة تنموية، وهو المتميز بالجدّ والمثابرة على أكثر من صعيد..
لقد سُعِدتُ بهذا التكليف، وبما أنني مازلتُ أعاني ومنذ أشهر في محاولة جَمع مادة لهذا الكتاب المُقترَح، وأعني بذلك كتاب الشعر الجديد، وبسبب الإستسهال أو التأثر بالوافد المُترجَم، أو بثقافة الفيس بوك أخيراً، فإنني مازلتُ أعمل على جمع ماتيسّر، بحيث أستطيعُ المُرافعة عما أختار، فإنني سوف أقترح بدايةً كتاباً للرواية، وكتاباً للقصصِ القصيرة، وليست القصيرة جداً، فلي وجهة نظر في هذه الأخيرة.
وإن كان لي حقّ الإشتراط، فإنني أشترط أن يكون الكتابُ معبّراً عن الإلتزام بالهمّ الوطني في ظروفٍ تتعرّضُ فيها سورية وكثير من الأقطار العربية إلى غزوٍ منظّم يستهدفها راهناً ومَصيراً.
ثانياً.. أن يكون الكتابُ تعبيراً عن أصالةٍ، لا أن يكونَ بلغةٍ مُستعارة، بجماليات مُستعارة، وأن يكونَ رافداً للأدب العربي المعاصر ومُرتكزاً إليه ومبشّراً بمستقبله.
ثالثاً.. أن يكونَ صاحبه، أو أصحاب الكتاب، من ذوي الموهبة العاملة على تطوير إمكاناتها من نَصٍّ إلى آخر، في الشعر كما في السرد، ولا أشترط عمراً.. إذ يبدو أنّ الكثيرين من الموهوبين والموهوبات في وطننا قد دُفِعوا إلى الظلّ بفعلِ الإضاءة على الآخرين، أو بفعل عدم الإنتباه.. فبعضهم أصدَرَ عدة مجموعات قصصية، أو شعرية، أو روايات، ولم يتسَنّ لها أن تكونَ حاضرةً في المُتابعات الثقافية، وأنّ هؤلاء غالباً ما يقطعون من قوتِهم أو قوتِ عيالِهم ليطبَعوا وينشروا نتاجاتهم، ورغم ذلك، مازالوا في ظلِّ المَشهَد.
ومن هنا، فقد اقترحتُ على نفسي أن أقدِّمَ لروايةٍ هي الآن مخطوطة بين يديّ، صاحبتها شاعرة وروائية، أصدرَت حتى الآن عدداً من الروايات ومجموعة شعرية واحدة..
صاحبة الرواية ليست شابة، وليست جديدة إلاّ من حيثُ أنها تكتب منذ مايزيد على الأعوام العشرين.. تابَعتُها في بداياتها من خلال برنامجي الإذاعيّ /عالمُ الأدب/ الذي استمرّ أكثر من خمسةٍ وثلاثينَ عاماً، كان فيها مَعنياً بالمبدعين الشباب والمبدعين الجدد، وقد ضمّت لائحةُ الشرفِ فيه أكثر من عشرين مبدعاً حصلوا على جوائز عربية ومحلية بعد أن كانوا مجرّد هُواة، لكنهم ثابَروا على تطويرِ مواهبهم وبَلوَرَةِ إمكانياتهم، فوصلوا إلى بُرهةِ الإنطلاق إلى فضاءِ المَشهدِ الثقافيّ في سورية.. وفاطمة صالح واحدة من هؤلاء.. عنوانُ روايتِها /إلى اللقاء يا أمي/ وهي أقرب إلى سيرة ذاتية في وعاءٍ روائيّ يسردُ للمُتلقّي يوميات سيدة تجلس إلى جوار أمها النائمة تحت وطأةِ /الكوما/ وتحدّثها عن ذكرياتها في ضيعة /المريقب/ القريبة من الشيخ بدر التي تضمّ ضريحَ الشيخ والشاعر العربيّ السوريّ /صالح العلي/.
وفي هذا السردِ المُمتِع تستحضِرُ أيضاً سيرةَ أبيها وذكرياته وحالته يوم كانت تعتني به وهو في حالةٍ شبيهةٍ بحالةِ الأمّ.
كلّ ذلك يتمّ على خلفيّةِ ما تعرّضتْ له سورية منذ الثمانينات يوم فقدتْ أيضاً أخاها الذي استُشهِدَ في خِضمِّ تلك الأحداث في حلب.. وصولاً إلى حالةِ سورية الراهنة وصراعِها مع الغزو القادم من الخارج مدعوماً بأعداء الإمبريالية من غرب متوحِّش.. ومال نفطيّ رجعيّ يستهدفُ سورية التي ضُرِبت كلّ الأهداف فيها، باعتبارها أهدافاً مُسجّلة على أجندة العمليات الصهيونية.
وإذ أقرأ الرواية، وأنا أسميها عملاً روائياً بامتياز، على الرغم من خصائص السيرة الذاتية فيه، حيث الشخصيات تحمل أسماءها الحقيقية كما في الطبيعة، في المكان والزمان.
وبما أنني زرتُ الشيخ بدر عدّة مرات، والمريقب، والتلال المحيطة، وضريح القائد الشيخ صالح العلي، فقد كنتُ في حالة تلقٍّ للرواية كما لو أنني أعيشها، فأنا أعرف والد فاطمة وزوجها وإخوتها والعائلة كلها تقريباً..
وكثيراً ما أسمَعَني أبوها الراحل، رحمه الله، بعضَ شِعره . فقد كان شاعراً أجّلَ نفسَهُ بعدَ عودتهِ من هِجرة إلى الأرجنتين، حيثُ أعادَهُ الحَنينُ إلى الشيخ بدر مَحمولاً على شوقٍ للإستقرار في وطنه.
قلتُ إنّ الروايةَ قد قدّمتْ لي كلّ المناخاتِ التي عشتُها، إن في مدينة الشيخ بدر، أو في مُحيطِها، كما أنني شاركتُ في دبكاتِها.. منها إلى صافيتا.. واستمَعتُ إلى العتابا والميجنا فيها.. كما شاركتُ في المهرجانات التي أُقيمتْ لتكريم القائد الشيخ صالح العلي.. وبالتالي، فإنّ الرواية أخذتني إلى فلسطين، وإلى قريتي فيها، حيث الإيقاعُ الغنائيّ الموروث فيها هو ذاتُه في الشيخ بدر، وحيث العلاقات والجيرة والكرم والتقدّم والتراجع والمُراوَحات هي ذاتها على صعيد المجتمع الصغير.
فاطمة صالح في هذه الرواية، تهدمُ الجدران حول المريقب، وقرى الشيخ بدر، والمنطقة.. باستقبال ووداع شهداء سورية المُحاربين الأشدّاء، والجرحى، والتوّاقين إلى العودةِ إلى مواصَلةِ معركةِ الوطن.. من هنا، فقد اقترحتُ على نفسي المُبادَرة لتكونَ هذه الرواية كتاباً مُرافِقاً لمجلةِ المعرفة السورية، شاكراً للصديق الدكتور علي القيّم تكليفي بهذهِ المَهَمّة.(
صحيفة الثورة2015/7/16
– والله، أستغرب، كيف تستطيعين الكتابة، بهذا الشكل، وهذا الإندفاع..!!
– هه ، حتى الأستاذ خالد، يقولُ لي ذلك…
لكنني، عندما أحاولُ أن أتجاهَلَها، تفرضُ نفسَها عليّ بقوّة.
ما الدافعُ إلى ذلك.؟ لا أدري.!
هل هو (توكيدُ الذات) كما يُقالُ في عِلمِ النفس؟!
أم رغبةٌ عارِمَةٌ بالخلود.؟! أم..؟!
بصراحة، لا أدري.
هل خُلِقَتْ معي هذهِ الرغبة.؟
هل توارثتُها من جيناتِ أسلافي.؟
أظنّ ذلك.
فالكثيرون منهم كانوا يعشقونها.