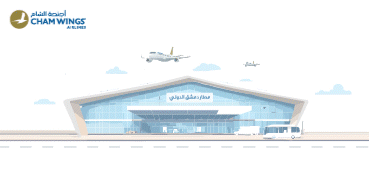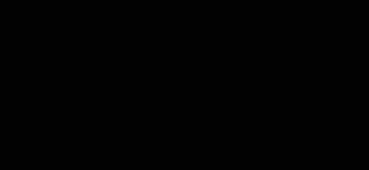( اليوم، عيد ميلادك، ياغالي……. بقدم لك هالياسمين اللي انت زرعته، قبل ماتسافر مع زوجتك إلى حلب، في أوائل ثمانينات القرن العشرين.. بعتت لي شتلة ياسمين مزروعة، ولبيي وأمي، كمان شتلة.. شتلتي ماصارت، ماحدا خبرني عنها حتى يبست… بيي زرع شتلتهم… وصارت، وكبرت كتير، وصارت تفيي على باب دارنا وتطلع عالسطح تدور عليك.. وبعد وفاتك، ياغالي، في ١/٥/١٩٨٦م كتبت عنك شعر حارق.. شافه بيي الغالي.. وبكي كتير كتير.. وبعت لي مع الغالي عمران، شتلة من نفس الياسمينة، اللي بقي يزرع منها ويوزع للاحباب والأصحاب، حتى راح لعندك….. هي بعض ورداتها، ياخيي.. صورتها قبل شوي عن البرندة قدام بيتي بالضهر….. بهديها لعينيك… وببشرك، انه رفقاتك بالجيش، رح يحرروا حلب، ياغالي… وصار الوطن بيقدر قيمة اللي بيحميه.. متلك ومتل رفقاتك، ياخيي… كل عام وكل لحظة، وانت فخر إلنا، ياخيي… بحبك كتير يااسماعيل….. لاتضحك من إفصاحي عن هذه البديهة، كعادتك……. كانت امي تخبرني شقدي كنت تنفر من كلمة ( بكره ) وكنت تقول: شو يعني بكره..؟! كيف الواحد فيه يكره..؟! كل الحب لعينيك الغاليتين… والرحمة والغفران لروحك الطيبة… والله يرحمنا ويغفر لنا تقصيرنا بحقكم، ياكنوز الوطن………….. وبوسة على جبينك، من خيتك فاطمة… اللي بتحبها كتير، وهيي بتحبك يمكن اكتر، وبتفخر فيك، ياغالي….
( اليوم، عيد ميلادك، ياغالي……. بقدم لك هالياسمين اللي انت زرعته، قبل ماتسافر مع زوجتك إلى حلب، في أوائل ثمانينات القرن العشرين.. بعتت لي شتلة ياسمين مزروعة، ولبيي وأمي، كمان شتلة.. شتلتي ماصارت، ماحدا خبرني عنها حتى يبست… بيي زرع شتلتهم… وصارت، وكبرت كتير، وصارت تفيي على باب دارنا وتطلع عالسطح تدور عليك.. وبعد وفاتك، ياغالي، في ١/٥/١٩٨٦م كتبت عنك شعر حارق.. شافه بيي الغالي.. وبكي كتير كتير.. وبعت لي مع الغالي عمران، شتلة من نفس الياسمينة، اللي بقي يزرع منها ويوزع للاحباب والأصحاب، حتى راح لعندك….. هي بعض ورداتها، ياخيي.. صورتها قبل شوي عن البرندة قدام بيتي بالضهر….. بهديها لعينيك… وببشرك، انه رفقاتك بالجيش، رح يحرروا حلب، ياغالي… وصار الوطن بيقدر قيمة اللي بيحميه.. متلك ومتل رفقاتك، ياخيي… كل عام وكل لحظة، وانت فخر إلنا، ياخيي… بحبك كتير يااسماعيل….. لاتضحك من إفصاحي عن هذه البديهة، كعادتك……. كانت امي تخبرني شقدي كنت تنفر من كلمة ( بكره ) وكنت تقول: شو يعني بكره..؟! كيف الواحد فيه يكره..؟! كل الحب لعينيك الغاليتين… والرحمة والغفران لروحك الطيبة… والله يرحمنا ويغفر لنا تقصيرنا بحقكم، ياكنوز الوطن………….. وبوسة على جبينك، من خيتك فاطمة… اللي بتحبها كتير، وهيي بتحبك يمكن اكتر، وبتفخر فيك، ياغالي….
بدي بشرك، ياخيي، بالخبر : الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون بشكل كامل على حي بني زيد في شمال حلب بعد فرار مسلحي “جيش الفتح” و “جبهة النصرة” ومجموعات “نور الدين الزنكي” مخلفين وراءهم أسلحتهم وعتادهم الثقيل….
ماعندنا لا كهربا، ولا انترنت… بس دخلت النت بواسطة (البيانات ) حتى لو دفعت مصاري كتير….. ومارح قول لك، اني متدينة شوي….. ولا يهمك حبيبي… كل عمرنا بنقدم فوق طاقتنا، لحماية وحدة، وحرية، هذا الوطن الأغلى…. المصاري بتروح وبتجي…. بس، الوطن إذا راح، صعب كتير يرجع…… لاتقلق ياخيي… صحيح الثمن غالي… بس الغنيمة اللي هيي الوطن ووحدته وقوته، أغلى ياخيي… ارقد بسلام، ياغالي…. واطمئن، إنه رفقاتك بدن يواصلوا درب التضحية، حتى تحرير هذا الوطن، الأم الكبيرة، وتقييد حرية العابثين والخونة ….. سلام عليك… ياعاشق السلام..
بست صورتك، وحطيتها لراسي، عدة مرات…. وأكيد مارح إشبع… وحرصت إني مابوسك محل اللي بستك آخر مرة بشوفك، وبرجع عالضيعة، ياخيي…. ووقت اللي جابوك ونزلوك من الصحية قدام بيتنا، كنت بتمنى رافقك وضل معك بالصندوق تحت العلم، وبالقبر كمان… بس بكي العسكري اللي كان يحاول يبعد الناس عن السيارة الصحية، بكي كتير وبمرارة، وقت اللي تراجعت انا، وانا مقول : خلص خلص… والله مارح بقا قرب.. خيي اسماعيل كان يحب النظام كتير.. وانا مارح اعمل غير اللي بيحبه..)
____________________
اليوم عيد ميلادك، ياغالي.. أهديتُ روحكَ الغالية، بعضاً من نقاء الياسمين، وكتبتُ لها رسالةً باللغة المَحكية، كما يدعونها، يعني، اللغة التي نتكلم بها في قريتنا، وفي المنطقة..
أكتبُ الآن، حولَ (مَحجوبة ) بالتأكيد، تعرف أن اسمها مُستعار.. طالما حدثتكَ عنها، وطالما استغربتَ مُعاناتها.. لم تكن لديكَ المقدرة على سَماعِها مباشرةً، إلا فيما ندَر.. كنتُ اصطحبها معي إليك، وأنا أعرف مقدار تعبك، لكنها كانت ترجو مَلاداً، وأحداً يستمعُ إليها، باحترام، ويساعدها على حَل مشكلاتها المُستعصية.. مرةً، قلتَ لها، وأنا أسمع : كيف لكِ ألا تتعاملي جيداً مع أبو هالة..؟! إنهُ رجلٌ طيب.. وأعقبتَ قولكَ ب : (هوي صحيح، ما إله دَيْرَة ) لكن، يجب عليكِ أن تتحمليه..
بكتْ، يومها.. ولم تعد تخبركَ بشيء..
وأنا، بدَوري، لم أعد أتعبكَ بهمومها.. يكفيكَ ما فيك..
لن أخبركَ الآن، كيف ماتتْ شقيقةُ روحي.. سأخبركَ لاحقاً…
أو.. لا. لا.. لن أخبركَ ياغالي..
نم قريرَ العين يا أخي..
فالوطنُ الغالي، الوطنُ الأم.. ينهض.. وستنهضُ معهُ روحُ مَحجوبة، كما ستنهضُ روحُكَ الطيبة، وكل الأرواح الطيبة، التي تعشقُ الخير..
كل عامٍ، وأنتَ فخرنا، ياغالي..
أختك
فاطمة
28/7/2016م
جدي (الشيخ سليم ) كانَ آخرَ مجاهِدٍ يُلقي سلاحَه. وكان ذلك، بعد تسليم قائد الثورة نفسَهُ للغزاة الفرنسيين، بعد تخفّيهِ عنهم لمدة طويلةٍ، بعد فشلِ الثورةِ لانقطاعِ الإمدادات، ولأسباب أخرى، كان الفرنسيون يحرقون القرى التي يظنون أنّ (الشيخ ) مختبىءٌ فيها، وأنّ سكّانها ينكرون ذلك. فيهجّ الناسُ إلى البراري أو القرى القريبةِ أو البعيدةِ، بحثاً عنِ الأمان، مصطحبينَ معهم أطفالهم ودوابّهم ومَرضاهم وعجائزهم، تلاحقهم طائراتُ الغُزاةِ، وتقتلُ مَن تقتل، وتروِّعُ الجميع.
سألَ القائد الفرنسيّ المُتغطرس، الذي سيحاكِمُ قائدَ الثورةِ بعد استسلامهِ القسريّ، ليخفّفَ الضغطَ على القرى والسكّان الفقراء المُدقِعين : لماذا تحاربوننا يا شيخ صالح..؟؟!!
فأجابهُ شيخُ المجاهِدين : نحن لم نذهبْ إلى فرنسا لنحاربَكم في شوارعِ باريس. أنتم مَن أتيتم إلى بلادِنا واعتديتم علينا، ولهذا نحاربكم، لنطردكم من بلادنا.
مما أغضبَ ذلك الفرنسيّ المُعتدي الشرس.
بصعوبةٍ بالغة، استطاعَ الشيخ الجليل أن يُقنِعَ جدي البطل (الشيخ سليم صالح ) بتسليم سلاحِه، وذهبَ معهُ إلى طرطوس، حيثُ سيتمّ التسليمُ في الثكنةِ العسكريةِ الفرنسيةِ هناك.. أدخلَ الحَرَسُ الشيخَ، بعد أن استأذنوا قائدهم داخلَ الثكنة، وظلَّ جدي واقفاً في الخارجِ، وبندقيتهُ على كتفه الصلد. وعندما طالَ انتظارهُ، دخلَ عليهما بسلاحهِ الكامل، فوجئ به الشيخُ، كما فوجئ بهِ القائد الفرنسيّ، سألهُ الشيخُ بتعجُّبٍ بالغ : كيفَ دخلت.؟! أجابهُ جَدّي : كما دخلتَ أنت. قالَ الفرنسيّ للشيخ : لو كانَ معكَ اثنان من المقاتلين بشجاعةِ هذا الرجل، لاستطعتَ أن تهزمَ فرنسا وألمانيا معاً.
في صيف عام 1977م، حَلّقتْ بنا الطائرة (بوينغ 747 ) أو (الجامبو ) التابعة للخطوط الجوية للمملكة المغربية، من مطار دمشق الدوليّ، في حوالي الثالثة صباحاً، بعدَ أن مَللنا من الإنتظار لساعاتٍ في المطار، مع بعضِ الأقاربِ والأصحاب الذين جاؤوا لتوديعِنا. الطائرة مخصّصة لنقلِ المُدَرّسينَ السوريّينَ المُعارين للتعليم في المدارسِ المغربية، وعائلاتهم. على حساب المغرب.
هيَ المرة الأولى التي أركبُ بها طائرة، وكذلكَ زوجي، وربما، الكثير من الرّكاب، أيضاً..
بالطبع، كنتُ خائفة، لكنّ (اسماعيل ) كان يطمئنني. خفتُ من الإنفصالِ عنِ الرّحم – الأرض. خفتُ من أنّ مَركبةً صُنعيةً تحملنا، وتسافرُ بنا، ونحنُ مُعَلّقينَ بين الأرضِ والسماءِ، بلا دعائمَ تسندها. وفي الوقتِ ذاتِهِ، كنتُ سعيدةً أنني أخوضُ تجربةً جديدةً، وأرى مناظر جديدةً، لم أكن أراها سوى على الخرائطِ الملوّنةِ والمُجَسَّمة.
هبطتِ الطائرةُ في مطار (أثينا ) الدولي، لبعضِ الوقتِ، قبل أن تعاوِدَ الإقلاعَ، وتتجهَ بنا غرباً، فوقَ البحرِ الأبيضِ المتوسّط، تحتَ الغيومِ، وفوقها، وأحياناً خلالَها، يتداخلُ جسمُ الطائرةِ بلفائفِ القطنِ الناعمة، ثمّ تتسعُ السماءُ أكثرَ، إلى أن بدَتْ لنا من النافذةِ بُقعةُ مُجَسّمةٌ ومُلونةٌ من الأرضِ تعومُ في ذلكَ الخضمِّ الأزرق،تبدو أكبرَ من أخواتها المُجاوِرات. سألتُ المُضيفَ المغربيّ الأسمرَ الجميل : ما اسمُ هذهِ الجزيرة.؟! أجابني (سيسيليا ). لم أفهم.. كرّرها لي عدّةَ مرات، ولم أفهم. فجاءَ بخريطةٍ مُخصّصةٍ لشركةِ الطيران المغربية، وأشار لي إلى موقعِ الجزيرةِ عليها، قال (اسماعيل ) : آ.. إنها جزيرة (صقلّية ) فعرفتُ أننا نقتربُ من منتصف الطريقِ الجوّي نحو المملكةِ المغربية.
___________________________________________
ومن فوقِ أسبانيا، حَوّلتِ الجامبو وجهتَها نحوَ الجنوب، بَدتْ لنا مناظرُ غايةً في الروعة، خريطةً مجسّمةً بالألوانِ الطبيعيةِ لتلكَ المساحة الضيقة من البحر الأبيضِ المتوسط، التي تصلهُ بالمحيطِ الأطلسي، والتي تُدعى (مُضيق جبل طارق ) وتفصل أراضي أسبانيا عن أراضي المملكة المغربية.. بدتْ لنا جبال أطلس الشاهقة، تتلوّى بين مفازاتِها أفعى زرقاء طويلة، قيلَ لنا أنها (نهر أطلس الكبير ).. منظرٌ كأنهُ حُلُمٌ جميل..
شعَرتُ برهبةٍ كبيرةٍ، عندما شاهدتُ الحدود البرية للمغربِ العربيّ، الذي كنا ندرس تاريخهُ وجغرافيتَهُ، وعددَ سكانهِ، وكلَّ مايخصّه، في مناهجنا التعليمية، كما ندرسُ كلّ قطرٍ عربيّ، هو امتدادُ لنا، كجغرافيا وتاريخ وسكّان وتضاريس وجيولوجيا ولغة.. إلخ وندعوه (الوطن العربيّ ) وما بعدهُ، يأتي (المحيط الأطلسيّ ) العميق جداً، والمجهول تقريباً بالنسبةِ لنا، ويفصلُ (وطننا العربي) عن العالَمِ الآخر، (العالَمِ الجديد ) المكوّن من (أمريكا ) الشمالية، والوسطى، والجنوبيّة………………. في أقصى جنوبها، في (الأرجنتين ) وُلِدتِ يا أمي، وتزوّجتِ أبي، وأنجبتما أخي (اسماعيل ) وحَمَلتِ بي، حتى شهركِ السابع، وأتيتِ مع أبي وأخي، في رحلةٍ بحريةٍ طويلةٍ جداً، ثمّ وَلَدتِني، في سوريا الغالية (المْرَيْقِب ) بعد وُصولكم إليها بخمسةٍ وعشرين يوماً… ومازالَ جَدّايَ – أبواكِ، يسكنانِ في قبرَينِ مُتجاوِرَينِ في مقبرةِ مدينةِ (الروخاس ) قرب العاصمة (بوينوس آيرس ).
كنا نقرأ، أيضاً جفرافية العالم كلّه، وتضاريسه، وجيولوجيته، وعدد سكانه، و.. و.. إلخ..
ظننتُ أننا وَصلنا إلى آخر الكرةِ الأرضية.. خفتُ، أيضاً، أن أنفصِلَ عن الرحِم – الوطن..
-يا ألله.. يا اسماعيل..!! لقد وصَلنا إلى آخرِ الدنيا..!!
حّطّت بنا الطائرة في مطار (الرّباط ) بعد حوالي خمس ساعات طيران، ثمّ أقلّتنا حافلات كبيرة كلٌّ مدرسٍ، وعائلته، إلى المنطقة التي عُينَ فيها.. اسماعيل، كان من المُدَرِّسين المُعَيّنين في مدينة ( أغادير ) في (إقليم سوس ) جنوبيّ المغرب.. أغادير مدينة صغيرة ساحلية جميلة، لم نكن نعرفُ عنها أكثرَ من أنها تعرّضت لزلزالٍ مُدَمّر في ستّينات القرن العشرين..
بعد نزولنا من الطائرة، بقينا مدة طويلة، والمسؤولون عن أمنِ المطارِ يفتِّشونَ أمتِعَتَنا بدقّةٍ بالغة، أثارتْ تذمُّرَنا، من التدقيق والزحام والإرهاق من السفر الطويل.. سألونا عن (البرغل )، وبصعوبةٍ بالغة، استطعنا أن نُفهِمَهم، بمساعدَةِ بعضِ المدَرّسين السابقين الذين كانوا باستقبالنا في المطار، أنهُ ( القمحة ) أو (الكمْحَة ) المطحونة، فسمحوا لنا بإدخالِه.. أمّا أقراص (الشنكليش ) فلم يستطعْ أحدٌ أن يُفهِمَهم ماهي، فرموها في سلّةِ المُهمَلات.. وكذلكَ (الكشك )، و (الزعتر المطحون ).
في (أغادير ) نزلنا في فندق (نَزل ) وبقينا لعدَةِ أيام، حتى استطعنا أن نستأجرَ بيتاً صغيراً مكوّناً من غرفتين صغيرتين ومطبخ ضيّق وحَمّام، في حارةٍ في وسطِ المدينة، تُدعى(تَلّبُرجت) وتسكن في الطابق الثاني من البناية، عائلتان سوريتان من (اللاذقية ).. وبعد مدة، انتقلنا إلى بيتٍ جديدٍ استأجرناهُ في حَيٍّ جديدٍ لم يكتمِل بناؤهُ بَعد، شرق المدينة، نحن وعائلة سورية، لم أنسجِم معها، لكنني بحاجة إلى جيرانٍ من الوطن، وكنتُ ما أزالُ أعاني من القلق وربما الكآبة، والخوف من البقاء بمُفرَدي، ولا أرتاحُ من تواجُدي في مكانٍ غيرِ مألوف. كانتْ الأبنيةُ الجديدُ تُبنى من طابقينِ، فقط، وتُسَلّحُ بشكلٍ مُقاوِمٍ للزلازل، عَصيٍّ عليها.. كانت عائلة (بيت الزّيّاتي ) تملكُ بيتنا الجديد، وتسكنُ في الطابقِ الثاني، بينما نحن والعائلة السورية، فنسكنُ في الطابقِ الأرضيّ، ولم تكن الشوارعُ قد فُرِشَتْ بالإسفلتِ، بعدُ..
(الزّيّاتي ) كان يعملُ مُخَدِّراً في مَشفى المدينة، زوجتُهُ الجميلة، لم أعُد أذكُرُ اسمَها، ربما (حليمة ).! وابنهُما الأكبر (محمّد ) في الصف (الحادي عشر ) وابنتهما (فاطمة ) في الصفّ التاسع.. من مواليد 1963م، وتكبرُ أختي (ندى ) بعامٍ واحِد، ممّا جعَلني أسعى لأن أعَلِّمَها كيفَ تكتبُ بالعربية كلاماً مفهوماً، لتتواصَلَ مع أختي (ندى ) برسائلَ مُتبادَلة، للتعارُف. بصعوبة بالغة كانت أختي ندى تقرأ رسائلَها، وأنا كنتُ أساعِدُ (فَدنَة ) على قراءة رسائل أختي، وفهمِ مَعانيها.
كانت (فَدْنَة ) السمراء النحيلة، مُدَلّلة عند أهلِها، وقويّةُ الشخصيّة، تبدو ضاحكة، غالباً.. أحببتُها وأحَبّتني، وأخبَرَتني، يوماً، أنها تكادُ تُقسِمُ أنهُ لاتوجَد طالبة في مدرستِها (الكولاج ) عذراء..! سألتُها، باحتجاجٍ واستغراب : وأنتِ..؟! قالتْ، مُستنكِرَةً : أنا..؟! لاااااااا….!!
_________________________________________
عُين زوجي في (المركز التربوي الجِهَوي ) الدي يدرس طلاباً وطالبات، تخرجوا من بعض المعاهد، منهم أكبر مني عمراً، وأصغرهم في سنّي. عانى من صعوبةٍ بالغة في شراء لوازِمِ المنزل، لم يكن يستطيعُ أن يُفهِمَ التاجرَ ماذا يريد، ولا أن يفهَمَ على التاجر ماذا يقول، حتى استعانَ ببعضِ المُدَرِّسين السوريين القدامى، فأفهَموهُ أنّ ( الشّطّابة ) تعني ( المِكنسة ) وأن (المَعدْنوس ) هو (البقدونس) و (الماطيشا ) تعني (البندورة ) وأنّ ( النيغرو ) تعني (الشاي الأسود )و ( الأتاي ) تعني (الشاي الأخضر ) الذي يُشرَبُ مع النعناع الأخضر، وهو المشروب المُفضّل في المغرب.. لكنني لم أكن أحبهُ كثيراً.
(بزاف ) تعني (كثيراً ) مع تشديد الزين.. (شْوِيا ) تعني (قليلاً ) (اللبن ) تعني (الحليب ) (الرايب ) تعني (اللبن ).. (نْدير ) تعني (نعمل ).. (مْشا ) تعني( راحَ ) (إيجي ) تعني (تعال ).. وغيرها من المفردات التي كانت خليطاً من العربية، والبربرية..
خفتُ جداً، عندما كنا نجلسُ في أرضِ الدارِ الداخليةِ، على البلاط، وتحتنا (طرّاحات ) إسفنجية، مع تلك الأسرة السورية المُكوّنة من ابنتَين، وثلاث ذكور، والأبوين..
شعرتُ أنني جلستُ تلكَ الجلسةَ سابقاً، في يومٍ ما..!! يا للهَول..!! أنا متأكّدة أنني جلستُ نفسَ الجلسة، وفي نفسِ المكان، ومع أولئكَ الأشخاص، لكن، متى.؟! وهي المرة الأولى التي أزورُ فيها المغرب..؟! لقد جُنِنت..!!
ولم أعرف ماهيّةَ هذا الشعور، سوى بعدَ عودتنا إلى الوطن، سورية، صيف العام 1980م، عندما صرتُ أقرأ في كتبِ الفلسفة (المعرفة والعمل ) التي أحضرَها لي زوجي من مستودَعِ الكتُبِ المدرسية، لأحَضِّرَ للتقدُّمِ للشهادةِ الثانوية، الفرع الأدبي، والتي نِلتُها عام 1982م. (الأدوية والمهدئات والدموع واضطراب الجسم كله والنفس، لدرَجة أنّني لعدّةِ دقائق، لم أستطع تثبيتَ يديَ اليُمنى لتُمسِكَ بأصابعها القلم، وتكتب، لو، حتى، اسمي، فقط، على ورقةِ الإمتحان.. واستعنتُ على تثبيتِها باليدِ اليُسرى، بعدَ أن توجّهتُ بروحي إلى السماء، أستجدي القوّةَ الخالقة، أللهَ تعالى، أن يُعينني، دون كلام، بالروحِ المُستجديةِ الضعيفة، وبعضُ الدموعِ تحرقُ خدّيَ المُتعَب، يا أللـــــــــــــــــــه… سبحانك…. أنتَ تعرفُ ما أريد، وتعرفُ مابي، فساعِدني، أرجوك.. يا ذا القوّةِ المُطلَقة.. يا أرحَمَ الراحِمين.
هَمَسَت لي إحدى المُراقِبات، أن أنظرَ إلى ورقةِ الإمتحان، فقط، وألاّ أتكلّم.. حَوّلتُ وجهي عنِ النافذة في الطابقِ الثالثِ من مبنى (ثانوية الكرامة ) في طرطوس، ابتسمتُ بأسى، لو تعلمينَ ماذا كنتُ أقولُ، أيتها الآنسة، ومع مَن أتكلّم..!!
شعرتُ أنّ إلهَ الرحمةِ استجابَ لي، وأعانَني، فكتبتُ اسمي، وبعضَ ما أعرفُ من إجابات على بعضِ الأسئلة، وقلتُ في نفسي: يكفي ماكتبتُ الآن، وفي العام القادم، سأكتب كلّ ما أعرفه، وما سأعرفه.. لم أكن أظنّ أنني سأنجح، ولم يكنْ النجاحُ حُلمي هذا العام، بل كان عامَ تجربةِ العودةِ إلى مقاعِدِ الدراسةِ، حُلُمي الأزليّ، منذُ تركتُ المدرسة بقصدِ الزواج قبل أن أكملَ السابعةَ عشرةَ من عمري.. وكان هذا بدَعمِ زوجي ورعايته.. كان يأخذني إلى طرطوس، كلّ يومٍ، تقريباً، بسيّارةِ بيك آب، طلب، بالإجرة، ينتظرني هو وصاحب السيارة، أمام المدرسة الثانوية، وعندما أخرج، نركب السيارة ونعودُ إلى القرية، وفي الطريق، يسألني كيفَ كان الإمتحان، ويناقشني فيما أخبره أنني كتبته.. وهَو صاحب فكرةِ أن أتقدّمَ للإمتحان، هذهِ السنة، فقط لتجربة التعوّدِ على جَوِّ الإمتحان.. بعدها أدرسُ أكثر، مُستفيدةً من تجاربِ هذا العام، أتقدّمُ في السنة الثانية، أو أكثر، حتى أتمكّنَ من الحصولِ على الشهادة، التي كانت حُلمي الأوّل الذي قُطِفَ عن غصنِ شجرةِ الأحلام الباسقة. لكنني نجحت.
ونِلتُ مئةً وخمسة عشرعلامة، منها ستّة عشر في مادّةِ الديانة/ التربية الإسلامية/..!! واستغربَ الناس.. وفرحَ زوجي وأهلي والمخلصين من الأصدقاء والمعارف، ارتفعَت معنوياتي بشكلٍ كبير، إلى درجةِ أنني قلتُ أنّ هذا النجاح المُعجزة، فعلَ بي مافعلتهُ حربُ تشرينَ التحريريةُ بنا وبالوطن الأغلى والمخلصين في العالم كلّه.
ومن لهفتنا لمعرفة النتيجة، وشدة توتري، اتصلتَ، يا أخي الغالي، بأحد معارفكَ في (إدلب ) حيث كانت أوراق (طرطوس ) تُصَحح، وجئتني بالبشارة..
في نفسِ العام، في وقتٍ قريب، جاءنا خبرُ وفاةِ جَدّي لأمي في الغربة، فكان الناسُ يأتونَ إلى بيتِ أهلي للتعزية بوفاةِ جدي (الشيخ سليمان صالح ) وللتهنئة بنجاحي..
قرأتُ في الفلسفة، التي كنتُ أهواها وأفهمها جداً، دون أن أدرسها سابقاً في المدرسة، لأنني لم أدرس الصفّ الحادي عشر، قرأتُ أنّ ما حصَلَ معي في /أغادير/ هو (من أخطاءِ الذاكرة) يحدثُ مع الكثير من الناس، وليسَ مَرَضاً، بل هو أمرٌ طبيعيٌّ جداً.. فتبَدّدَ خوفي، وتحوّلَ إلى مَعرِفة.
تضاعفتْ آلامي النفسية والجسدية، إلى حَدٍّ كبير، بعد وفاةِ أخي الغالي، عام 1986م.. كما تضاعفتْ آلامُ العائلة كلِّها، والأقارب، والمعارف.. (اسماعيل صالح، رَخّصَ الموت ) كانتْ هذهِ العِبارة تتكرّر، وبقيت، إلى وقتٍ طويل..
وفي تلك السنوات العصيبة، قرّرتُ الحصولَ على الشهادةِ الثانوية، للمرةِ الثانية، لكن.. بتعَبي، هذهِ المَرّة، ودون الإعتمادِ على أحد.. وكانتْ لي كلُّ المُبَرِّرات.. فاشتريتُ كتُباً من مستودعِ الكتُب المَدرسية، كانت تنقصني، وبدأتُ التحضيرَ لذلك.. في الكثير من المَرّات، كنتُ أهربُ من المنزلِ، وأجلسُ في ظلِّ شجرةِ التوتِ الكبيرة، التي كانت لبيت خالتي، وطالما دَعَتنا خالتي لأن نطلعَ إلى الضهر، ونحن صغاراً، لنأكلَ من حَبِّها الأبيضِ اللذيذ، قبل أن يقطعوها، ليطعِموا أوراقها للدّواب، أو لدود الحرير.. أصطحِبُ معي إبريقَ ماءٍ، ودواءً مُهَدِّئاً، وآخرَ مُضادّاً للتشنّجِ، ومُضادّاً لحموضةِ المَعِدة، وبعضَ الكتبِ، والدفاترِ، والأقلام، والمناديل الورقية.. أشهَقُ، أشهقُ، وأشهق.. تغسلني الدموع.. وأتّجِهُ نحوَ السماءِ، مُستجديةً رحمتَها (ياعالماً بحالي، عَليكَ إتكالي ).. أستفيدُ ممّا قرأتُهُ في أحدِ أعدادِ (مجلة المرأة العربية ) عن تمارين اليوغا، والتأمُّل، والتفكير بالأشياءِ الجميلة التي تريحُ نفسي.. فأتأمّلُ الطريقَ المُحَصّى، والمُترِب، الذي يصعدُ من قربِ النهرِ، إلى قريتي الغالية (المريقب) وأتصوّرُ أنّ فلاّحاً بسيطاً طيّباً، أنهى عملهُ في الحراثةِ، للتّوّ، وحَمَلَ (النيرَ) على كتفهِ، وساقَ دابّتيّ الحراثةِ أمامهُ، وراحَ يملأ الوادي بال (أووووف )، وترَدِّدُ الجبالُ والتلالَ مَوّالَهُ الدافئ، الذي يساهمُ بالتخفيفِ من تعبه، وأتحسّسُ الراحةَ التي يحسُّ بها، وأعيشُ البساطةَ التي يعيشُها، حتى ولو لدقائقَ معدودة، لكنها كانت كفيلةً بأن تمنحَني قدراً من الإسترخاء، فأتنفّسُ بعُمقِ، عدّةَ مرّات، وأستعينُ بالله، وأبدأ القراءةَ، أدعَمُها بالكتابة، لترسخَ في ذهني، أكثر.. وهكذا..
اتصَلتُ بأختي الغالية (آمال ) التي تصغرني بأكثرَ من عامين، إلى بيتِ أهلي، محاوِلةً أن أبدو طبيعيةً، وأنا أخبرُها أنني سوف لن أنزلَ معها إلى طرطوس، ولن أتقدِّمَ للشهادة، وهي التي كانت قد اصطحبتْ طفليها، بمرافقةِ زوجها الغالي (حسن ) إلى القرية، بغرضِ اصطحابي إلى بيتهم، لأستريحَ يومَين، قبل موعد الإمتحان، وأبقى عندهم إلى نهايته.. وما إن سألتني الغالية، باستنكارٍ، عن السبب، حتى لم أعدْ أتمالكُ نفسي من النحيب، حتى كدتُ أسقطُ أرضاً.. لم أكن بحاجةٍ لأخبرَها عَمّا دَهاني، لأنها تتوقّعُ، كالعادة.. فنهَرَتني، وشتمتني، على هذا القرار المُستنكَر.. وعادتْ واتصَلتْ بي لتقولَ لي : جَهّزي نفسَكِ، سنستأجرُ سيّارةً، ونطلعَ إلى منزلكِ لاصطحابكِ معنا.. وعندما أخبرتُها بصوتٍ يجرح، أنني غيرُ قادرة على التقديم، ولا أستطيعُ نزول الدرَج.. قالت لي : لا عليكِ، اصطحِبي كتُبَكِ، ولا تتقدّمي.. وسأساعدكِ بالخروج من المنزل، ونزول الدرج…. وكان دلك..
– كَفاكِ إلحاحاً، يا مَحجوبة….
____________________________________________
تذكرين، يا أمي..؟!
عندما كنتُ أخبركِ، وأنا أرقّ لكِ قِطعَ العجينِ الدائرية، وأهلّها، وأنشرها على (الكارة ) حيث تسوّين أطرافها، وتلصقينها في بطنِ التنّورِ المغزليّ، من الجانبين، والجَمْرُ يتوقّدُ في قاعِه..
أخبركِ عن (مغامراتي العاطفية ) ههه.. أنني أعشقُ الأستاذ الفلاني، وألاقي لهُ، أنا و (هند ) عندما يكون آتياً من بيتهِ، قاصداً (المَدرسة ) والتي هي عبارة عن عرفتين إسمنتيتين متلاصقتين، تحت الطريق، والثالثة، يفصلها دربٌ صغيرٌ عن الغرفتين.. للصفوف (السابع ) و(الثامن ) و (التاسع ) الرّسميّ، وأخرى – وهيَ الإدارة – فوق الطريق، أو الشارع الرئيسيّ في (الشيخ بدر )..
وكانت هناكَ، ما تزالُ (المدرسة الخاصّة ) التي تعلّمَ فيها مَن قبلنا من طلاب وطالبات، منهم من لم يتمكّن أهلهُ من إرساله إلى طرطوس، ليتقدّم لامتحان الشهادة الإبتدائية، فسجّلوهُ، مباشرةً في المدرسة الخاصة، ومنهم مَن لم ينجح في الإمتحان، فعلّمهُ أهلُهُ فيها، على حسابهم..
عام 1967 و 1968 و 1969م.. هيَ سنيّ دراستي الإعدادية الرسمية..
فتضحكينَ ملءَ رئتيكِ، على عِشقيَ البريءِ ذاك، وتنبّهينني، كصديقةٍ تنبّهُ صديقتها، أنّ عليّ الإستمتاع بهذهِ المشاعر الطبيعية، في هذهِ السنّ الغضّة، لكن عليّ أن أدركَ أنهُ (عشقٌ ) مؤقّت، وليس للزواج…!!
عشقي هذا، كان لايتعدّى مشاعرَ إعجابٍ داخِليّ، وحبّ بريء، وأنا شبه جازمة، أنّ ذلكَ (الأستاذ ) كان يخجلُ عندما يسمعُ من زملائي، وزميلاتي، وحتى من زملائهِ الأساتذة، أنني أعشقه.. ولا أكتمُ هذا الغرامَ الذي يهزّ كياني، لكنه لا يحرّكُ في كيانهِ شيئاً، ما عدا الخجل..
في أحد الأيام، جاءتنا الرسالة الثانية من (أبو صالح ) أخ اسماعيل، الأكبر، وهو عسكري متقاعد، وهي عبارة عن ورقة عادية، وقصاصة صغيرة.. قرأ زوجي، وقرأتُ، الرسالة.. وأخفى عني القصاصة، لمدة قصيرة.. وكانت عبارة عن خبرٍ مؤلمٍ جداً، خافَ المرحوم (أبو صالح ) أن يسبب لي سَماعُه المزيد من التوتر.. وفاة (زينب ) بنت (الشيخ علي عبد اللطيف ) إثر نزيف حاد، ناتجٍ عن تمزقِ رحمها، وهي تلدُ طفلتها الأولى، التي أسموها باسمِ أمها.. ولم يستطع زوجُها العسكري، إنقادها، ولا أعرف إن كانت خدمته قد سمحت له بأن يحضر ولادة زوجته بطفلهما الأول، لكن، المهم، أن المنطقة التي كانوا يستأجرون فيها بيتاً، وربما غرفة، كانت بعيدة عن دمشق، ضمن الأبنية العشوائية التي بناها القادمون مناطق الظل، أو، المناطق البعيدة عن العاصمة، التي كانت خدمتهم فيها، أو حَولها..
ماتت زينب، الشابة الشقراء الجميلة الخلوقة، قبل وصولها إلى المشفى.. وكانت محترمة جداً، لأصلها الطيب، ولعنايتها بحماتها البائسة (فضة ) (أم محمد ) أخت الشهيد (أبو علي ) (صالح محمد صالح ) التي توفيت، أيضاً، إثر ولادتها لطفلها الثامن (ربما ) وكانت تعاني من فقر الدم الشديد، وزوجها يعمل في (لبنان ) بعد انتهائه من عمله الموسمي، في أرضهم، وبمساعدة زوجته وأطفاله القادرين.. كان ابنها البكر، زميل دراستي، يشفق على أمه المظلومة، كثيراً، ويساعدها في أغلب أعمالها، حتى في رق الخبز على التنور، أو إحضار (الحْماية ) وغير دلك..
___________________________________________________
انقطعت رسائل أهلنا، مدةً، ثم كانت رسالة من (يوسف عمران ) (أبو ياسر ) إبن خالة أبي، وصهر اسماعيل.. يخبرنا فيها بمرضِ (أبو صالح ).. تلتها رسالة، عن تحسنه.. وأخرى… عن وفاته.. في التاسع من أيار عام 1978م.. رحمه الله…
وقعَ الخبرُ علينا كالصاعِقة.. لا هاتف نستطيعُ معه التواصُلَ مع سوريا.. ولا وسيلة اتصال سوى الرسائل التي تأتي إلى السفارة في (الرباط ) في شمال المغرب، وبعدها إلى (أغادير ) وقد يستغرق وصولها، في حدهِ الأدنى، عشرة أيام، أو نصف شهر..
في دلك العام، عدنا إلى الوطن، بعد انتهاء العام الدراسي، بطائرةٍ، تابعةٍ لمؤسسة الطيران العربية السورية، من نوع (بوينغ 136) على ما أظن… عبرت بنا الوطن العربي، وتجنبتْ مطار (القاهرة ) الدولي، بسبب انقطاع العلاقة بين شطري الوطن، أو جناحيه، الدي انقص إحداهما، عبر اتفاقية الإدعان والخيانة، التي وقعها (السادات ) مع العدو الصهيوني..
كنتَ، يا أخي الغالي، باستقبالنا، مع زميلين لكَ، في الجيش، بواسطة سيارة عسكرية عجوز، ربما يسمونها (لاندروفر ) والله لا أعرف.. المهم، أنها كانت سيئة جداً، ومُتعِبة.. لكنها أراحتنا من التنقل بين وسائل النقل العامة.. حتى وصلنا إلى دمشق..
ومن بعدها، بواسطة وسيلة نقل عامة، إلى حمص، ثم إلى طرطوس، ومن طرطوس، إلى (الشيخ بدر ) ثم إلى القرية… حيث كان اللقاء مأساوياً…
رَحَل (علي محمد اسميعيل ) (أبو صالح ) الرجل الشهم، الرقيب أول المتقاعد، الدي لم يكن يكفيه راتبه التقاعدي، وهو يعيل أسرةً من عشرةِ أبناء وبنات، وزوجة.. وما يزيد أمهُ وأباه، العجوزين، ألماً.. دلك الخلاف الدي كانوا يحدثونني عنه، وهو بين زوجته، وأخيها.. وبين أهل زوجها.. وانعكس دلك، على علاقةِ ابنهما البِكْر، بهما، وبالعائلة.. ولم تدع زوجته، أخته الكبرى (أم عباس )، التي جاءت لتحضر جنازة أخيها الأكبر، لم تدعها تودعه، لأنه – كما قالت – كان قد أوصى بأن لايسمحوا لها بدخول بيته، لافي حياته، ولا في مماته.. و (يصطفلوا )..!!